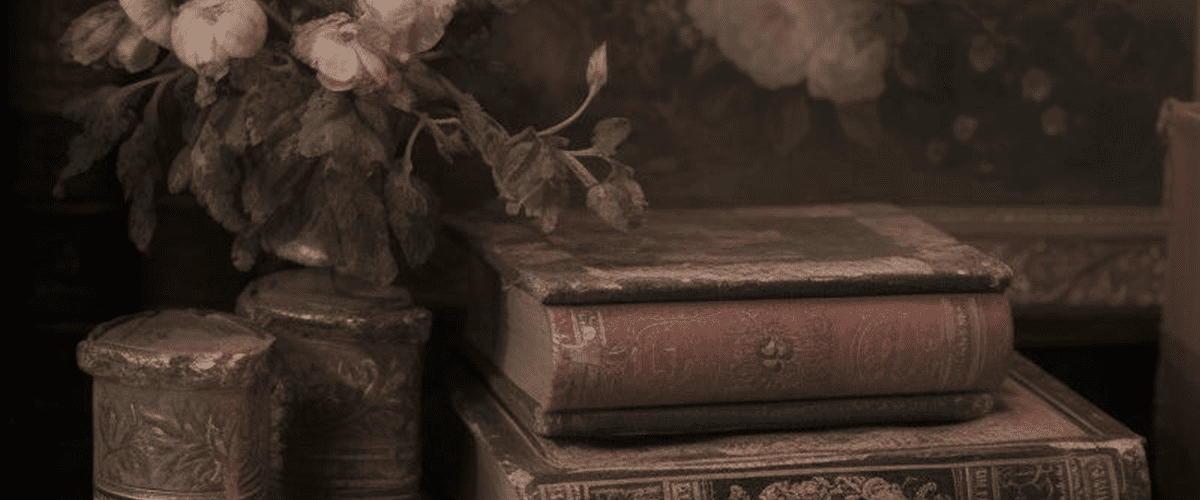حبيب الصايغ.. رَسَمَ وجْهَهُ فتشَكَّل العالم! | شعبان البوقي

شعبان البوقي
شاعر وكاتب مصري
يتساءل الكاتب والشاعر الأرجنتيني الشهير خورخي لويس بورخيس:
“ما هو الزمن؟! إنه النهر الذي ينفلت مني.. لكنني أنا النهر! إنه نمرٌ يفترسني.. لكنني أنا النمر! إنه النار التي تلتهمني.. لكنني أنا النار! العالم -للأسف- هو أنا.. العالم هو بورخيس”.
بعد كل هذه التجربة الممتدة والعميقة يكتشف بورخيس صدمته، ويصدمنا جميعًا معه، بأن العالم الذي حاول رصده وتفسيره ما هو إلا بورخيس ذاته، وها هو يُصرِّح في كتابه الخالق قائلًا: “في آخر صفحات الكتاب تحدَّثتُ عن رجل يحاول أن يرسم صورة للكون.. ولكنه اكتشف في لحظة موته أنه رسم وجهه هو!”.
هذه الحقيقة التي بدت له وصدمته بعد كل هذا العناء؛ فطن لها شاعر العربية الكبير حبيب الصايغ منذ بداياته مع الشعر، حين أدرك أن الذات المفردة وفهمها هما السبيل الأقدر للخلْق الشعري وصياغة العالم لينطلق من الذات ودواخلها إلى الخارج. حيث المفرد هو المجموع في حقيقته، لنجد أن تجربته الشعرية ذاتيةً انطلقت من تفرُّدها لترسم لنا عالمًا مدهشًا صاغه برؤاه الفلسفية النابعة من الداخل والمكنون فيه.
ربما كان هذا المنحى هو السبب الأكثر موضوعية لمجايليه من المبدعين والنقاد حين وصفوه بالغموض والإبهام. هذا المفرد الذي انطلق منه “الصايغ” لتشكيل عالمه الشعري بدا لنا منذ أن قدم أول ديوان له وهو (هنا بار بني عَبْس) في عام 1980 تلك القصيدة الطويلة التي تتناول سيرة عنترة بن شداد محتفيةً بالهم الفردي والبحث عن الحرية الشخصية كمنطلق لتحرير العالم بكامله لا العكس. فهو لا يكتب عن فارس مقهور من منظور البطولة بل يعيد قراءة عنترة قراءة مغايرة تنظر إليه من خلال احتفائه بذاته والبحث عن حريته ومجده الشخصي الذي لا يعير انتباهًا لباقي العبيد كما يقول “الصايغ”. إن هذا المنحى الفلسفي لفهم حرية الإنسان التي تبدأ من تحريره لذاته وإعلائها لبناء الكون كان حاضرًا في شعر حبيب الصايغ طوال تجربته وكأنه يقول لقارئه: “أنا العالم.. ستكتشفه باكتشافي” وربما كانت تلك النزعة الوحدوية عنده نتيجة موضوعية لمتصوف اعتمد النظرة العميقة للنفس وعوالجها وبواطنها منظارًا دقيقًا لتفسير العالم ونواة لتكوين الوجود الشعري الخاص به.
فها هو يؤكد على نظرته الأولى وفلسفته بديوانه الثاني الذي نشره عام 1981 ويعلنها بعنوان مُبين أسماه “التصريح الأخير للناطق باسم نفسه” وهنا يؤكد بما لا يدع مجالًا للريبة أنه قادم للخلْق الشعري من منطلق الحديث عن نفسه هو، حيث تفرُّده وحده القادر على حمل الشعر وطنًا للإنسانية، رافضًا الاستيراد من الخارج للتعبير والمحاكاة عنه، حيث ذاته هي العبور للمطلق الرحب. وحبيب الصايغ هنا يضع لنا قاعدة رئيسية للإبداع وهي أن الخلق عند الشاعر يبدأ من ذاتيته؛ فهو الراصد لهمسها ليستمع لهمس الكون من حوله، وهو المنكفئ عليها ليجعلها قاربًا يعبر به من أراد الإبحار في الفن. فها هو يصرح عن ديوانه الأول قائلًا: “وفي إحدى الليالى كنت أكتب فى القصيدة، وجاءت فى خاطرى الجملة الشعرية «تُشاغِلُني البِيدُ فى ذروةِ الوحدةِ العاقلة» فوجدت أن هذه الجملة هى مطلع القصيدة وأن ما كتبته خلال العامين السابقين يجب أن ألقيه فى سلة القمامة”.([i])
لقد فطن أن ذروة الوحدة العاقلة هي المسلك الحقيقي لفهم الإنسان، مقررًا أن يلقي كل ما سبق في سلة المهملات ليبدأ رحلة القبض على حقيقة فهم الإنسان والشعر.
تلك النظرة الفلسفية والحقيقة التي أدركها “الصايغ” جعلتنا نطالع شاعرًا رائدًا قديرًا من أعمدة الحداثة في الشعر العربي، وهنا لا أريد أن أقول الإماراتي وحسب، فهذا التصنيف قد يمنحه فخرَ الموطن العظيم، لكنه قد يسلبه حقَّهُ في مشهد القصيدة العربية التي كان واحدًا من فرسانها المجدِّدين والمجرِّبين بها تجريبًا لا يحتفي بالتمرد على شكل مُعين ولكنه تجريب ينطلق من التفرد في النظرة والمجاز الذي ينطلق دائمَا من نفس وحيدة متأملة تقدم رؤيتها للعالم، خالقةً لا معبرةً، فهو الذي يقول عن نفسه : “أنا متفرد” وهنا لم يكن مغرورًا أو متعاليًا، لكن القراءة الموضوعية المتفحِّصَة في منجزه الشعري ستجد خلَّاقا قادرًا على الدهشة والقبض على رؤى ومعانٍ ونوايا متفردة، طارحًا فلسفة شعرية مغايرة من زاوية بعيدة وخاصة لا يشبهه فيها أحد ولم يتشبَّه فيها بأحد.
فعلى سبيل الشكل استطاع أن يكتب القصيدة العمودية والتفعيلية وقصيدة النثر، مصرِّحًا بأنه لا يرفض شكلًا بعينه ولا ينتصر لجنة بعينها حيث يقول: “كتابة الشعر ليست «لعبة»، لذلك أحاول أن أكون جديدًا وأن أقول ما لم يقله أي أحد قبلي، ولا يمكن أن يقوله أحد غيري، وأن يكون هناك تجريب دائم وشكل جديد ومضمون جديد، لذلك أنا أكتب الأشكال الشعرية الثلاثة القصيدة العمودية، وقصيدة التفعيلة، وقصيدة النثر، وهذا مهم ففي رأيي ليس هناك شكل شعرى يقوم بإلغاء شكل آخر”([ii]).
هذا الفهم جعل حبيب الصايغ لا يقدس الإطارات لكنه يسعى للنفاذ لجوهر الشعر، الذي هو ذاتي لا يقبل عنده أن تشوبه شائبة ابتلاع طُعْم الآخرين، فهو يطرح نفسه بأسئلتها وبحيرتها وبأحزانها وتأملاتها الخاصة لينطلق من داخلها لصوغ عالمه الرحب الفَتَّان، فأسئلته شجرُ الآخرين، وهو الذي رسَمَتْهُ البيدُ، وركضت نحوه السواحل، وأبصر مالا يراه غيره.. بل إن رثاءه وموته انتهاء للحضارات.
“أؤسِّسُ أسئلتي في الفراغِ،
فيستدرجُ الشكلُ ظِلِّي إلى وحشَةِ الحُبِّ
أدفن أسئلتي في حديقة بيتي،
فيطلعها صاحبي شجرًا
لا سماءَ سوى ما انتهى
فَدَعيني أقلْ ما أشاءْ
مرةً، حين داهمني الموتُ
أبصرتُ ما لا يُرى
وحيدٌ أنا
ضائعٌ كالفصولِ الشريدةِ
إنَّ الرثاءَ انتهاءُ الحضاراتِ
فلتَرْبِطوني إلى شاهدِ القبرِ كي ما أُغَنِّي!
وحيدٌ أنا
البِيدُ حَوْلي ترْسمُني من جديدٍ
وتركضُ نحوي السواحل».
لقد آمَنَ حبيب الصايغ أن التفرد هو السبيل الأوحد ليُتَوِّجَهُ الكونُ شاعرًا، حين قال: “لولا شعوري، بل يقيني بأنني متفرد؛ لما نشرتُ شعرًا ولما قلتُ إني شاعر. في الشعر لا توجد منطقة وسطى.. إما أن تكون شاعرًا متفردًا وإما لا تكون”([iii]).
إن سيطرة الأنا على شعر حبيب الصايغ لم تكن من قبيل النرجسية، لكنها المرآة التي يجب أن ينظر فيها الكون والشعر ليجد نفسه. بل إن الموت عند حبيب الصايغ أضعف من محو الإنسان والفنان، فهو يدركه ويتصالح معه ويتحداه ويراه.. قبل أن يأخذ حبيبًا في غياهِبِه البعيدة. وفي هذا يقول: “الكتابة تمرينٌ على الموت، أنا أتوقَّع أنني سأموت فجأةً في يومٍ من الأيام، وهذا تمرينٌ على الموت، فالكتابة كالحُب تمامًا”([iv]).
“لا يُناسِبُني أيُّ شيءْ
لا يُناسِبُني الغزَلُ الصِّرْفُ هذا المساء
ولا أدَّعي أنني عاشقٌ..
يُعرَف العاشقونَ
بأسمائهم واحدًا واحدًا
وأنا لا يُناسبني أيُّ شيء
ولستُ أنا، غير أنِّي انتظرتُ بهاءَكِ
منذُ ازدحامِ سمائي ببرقِكِ
منذُ اكتمالِ دمي
في مرايايَ
أو تَعَبي في خلاياي
يا أنايَ البعيدةَ فيَّ
ولا ألتقيكِ لأنكِ أقربُ مِنِّي إليَّ”([v]).
وليس من دليل على قهرِهِ للموت أوضح من ديوانه الخالد “أُسَمِّي الرَّدَى ولدي”، الذي قدَّم فيه رؤية فنان تغلب على الموت واحتواه فكان ابنه، لأن مقامه أكبر منه في رحاب الخلود، فهو المُصِرُّ على نسب الموت له، وكأنه هو أبوه ومن أتى به للكون، وهذا أكبر دليل على احتفائه بذاته في شعره.
“كذلك قالَ العدم
فانثنيتُ إلى الخُلْدِ عَلِّي أُقاوِم فيهِ فُضُولي
وأقنَع بالنومِ أو بالقراءةِ أو بالندمْ
أو باختراعِ الأباطيلِ
أو صُحْبةِ الأُسْدِ في الغابِ
أو بمحاورةِ امرأةٍ سبَقَتْني إلى الغيبِ والجَوُّ صَحْوٌ ومنتَشِرٌ
في نواحي الأبدْ
وبالموت…
حتى إلى الخُلْدِ تلحَقُني يا ابتدائي
أردتُ أقول: وحتى إلى الخُلْدِ تَلْحَقُني يا وَلَد؟!”.
لم يكن حبيب الصايغ بعيدًا عن هَمِّ أمته وحضارته ووطنه، لكن الوطن والأمة والأماكن عنده تخضع لقوانين الذات والتصاقها بها وفهمها من الداخل واستخلاصها من أعماق النفس؛ لا رصدها والتعبير عنها كآثار وطرق سلكها قبله الآخرون يتلمسها أو يرسمها ويحاكيها.. بل يخلقها على عينِه وينفخ فيها من روحه الشاعرة، فتراها مغايرةً فاتنةً كأنَّك تراها لأول مرة وذلك هو الفرق بين الخلْق والتعبير.
فحينما تناوَلَ قضية فلسطين مثلًا، وجدنا كيف انداحَ الجمعيُّ والقوميُّ في الذاتيّ، وكيف أن حزن الإنسان الشخصيّ وهمومه هما المحرك لكل قضية كبرى.
“ما الذي أنتَجَتْه الحروبُ الأخيرةُ
قُلْ !
ما الذي أنتَجَتْهُ الحروبُ الأخيرةُ؟
دَعْ عنكَ حُزني الخفيفَ
سأتركه جانبًا
وأقاتلُ من أجل كلِّ فلسطين
واللافتاتِ الجميلةْ
وأعشقُ كل بناتِ القبيلةْ
سأقاتلُ من أجل كلِّ فلسطين”([vi]).
إن الهوية إبداعيًا -كما يرى الشاعر والمفكر الكبير أدونيس- هي أن تحيا وتفكر وتعبر كأنك أنت نفسك وغيرك في آن، بحيث تبدو في لحظةٍ ما كأنك الكل في واحد، فالإنسان في الإبداع مشروعٌ لا يكتمل، والشعر ليس أجنبيًا على الذات، وهو بُعْدٌ مِن أبعادِها وصورتها الثانية، والآخر ليس بالضرورة هو الانتماء القومي أو التراث أو الهوية الجماعية أو الأيدولوجية، وإنما هو الإنسان المفرد، كالذات، أي هو الوعي الإنساني الشخصي الذي يواجه الكون، ويحاول أن يكتبه.[vii]
وهذا معنى كبير يلخِّصُه حبيب الصايغ قائلًا:
“في حياته، منذ وُلِدَ،
وهو لا يرى إلا موتَهُ
في الينابيع وزجاج النوافذ والقطارات..
وعندما مات أخيرًا
اكتشف أنَّ ما كان يراهُ طيلَةَ حياتِهِ ليسَ
الموت!
يتذكر ويضحك ..
ويُهيل بيديه على وجهه
شلَّال ورد .. ويضحك”.
كان حبيب الصايغ يرفض الاستسهال في الشِّعْر، فعلى حَدِّ قولِهِ: هناك ذائقةٌ قد تُدَمَّر بنشْرِ ما لا ينبغي نَشْرُه. وإذا نظرنا لمنجزه الشعري سنجده المتحدث باسم نفسه، المُتَفَرِّد الأُمَّة، المنتصر للإنسان متمثلًا في ذاته، المُسَمّي الرَّدَى وَلَدَهُ ليُرَوِّضَه، والراسم وجْهَهُ ليتشكَّل العالم.. سلامٌ لروحِه في الأعالي.
[i]( حبيب الصايغ: لقاء خاص مع صحيفة البوابة نيوز، القاهرة، مصر، الأربعاء 21/أغسطس/2019 – 10:00 م
[ii] نفسه
[iii] حبيب الصايغ: أنا متفرد··· صحيفة الاتحاد، الإمارات، 24 يوليو 2008 00:10
[iv] حبيب، الصايغ: حوار مع الشاعر في مجلة نزوى، عمان : 1 أكتوبر,1997
[v] الأعمال الشعرية – حبيب الصايغ – الجزء الأول – اتحاد كتاب وأدباء الإمارات – 2012م – ط 1 – ص : 58
[vi] حبيب الصايغ: الأعمال الشعرية، الجزء الأول، اتحاد كتاب وأدباء الإمارات – 2012م – ط 1 – ص :43
[vii] أدونيس: سياسة الشعر ، دراسات في الشعرية العربية المعاصرة، دار الآداب – بيروت، ط1، 1985 م، ص : 69و 70