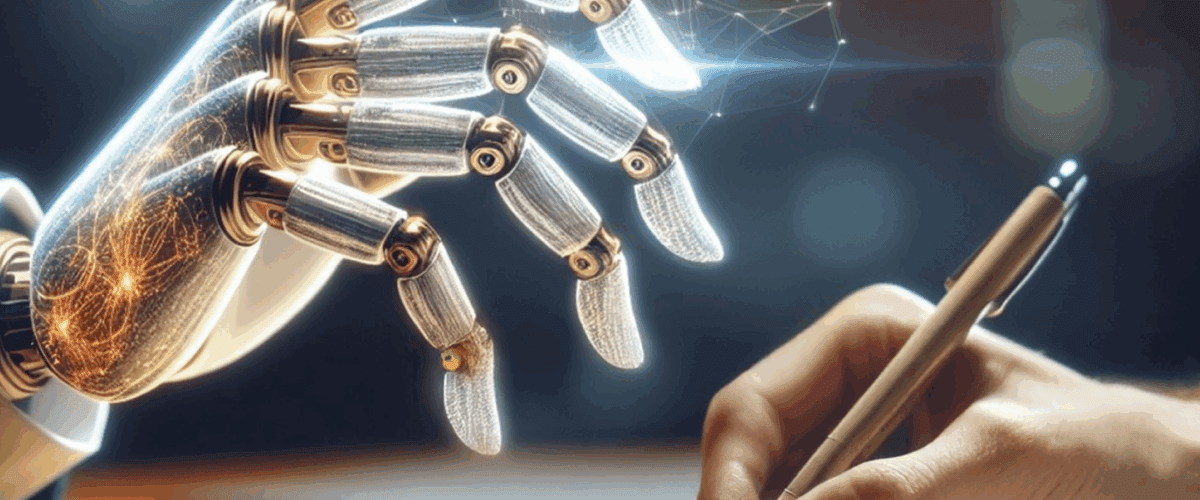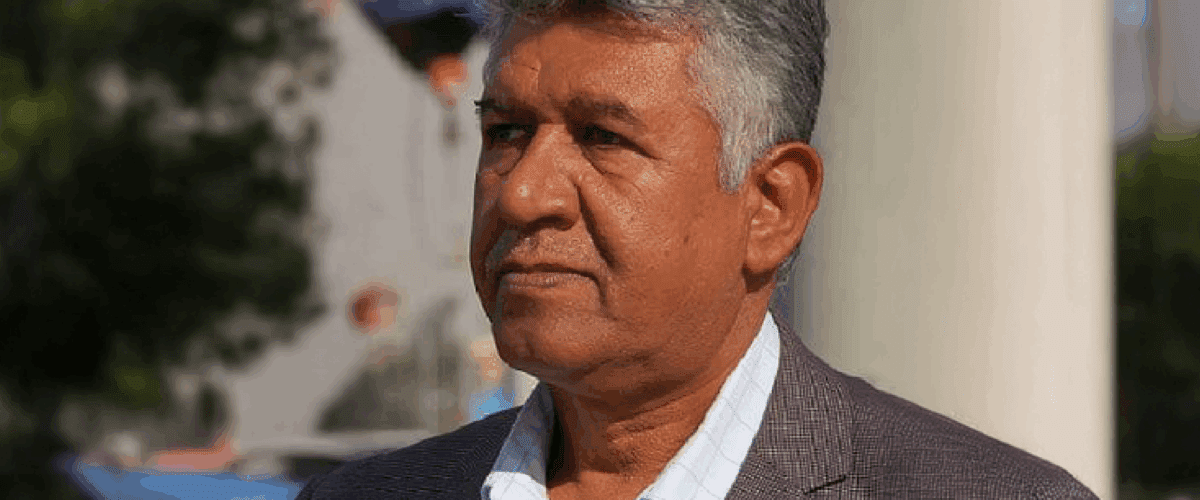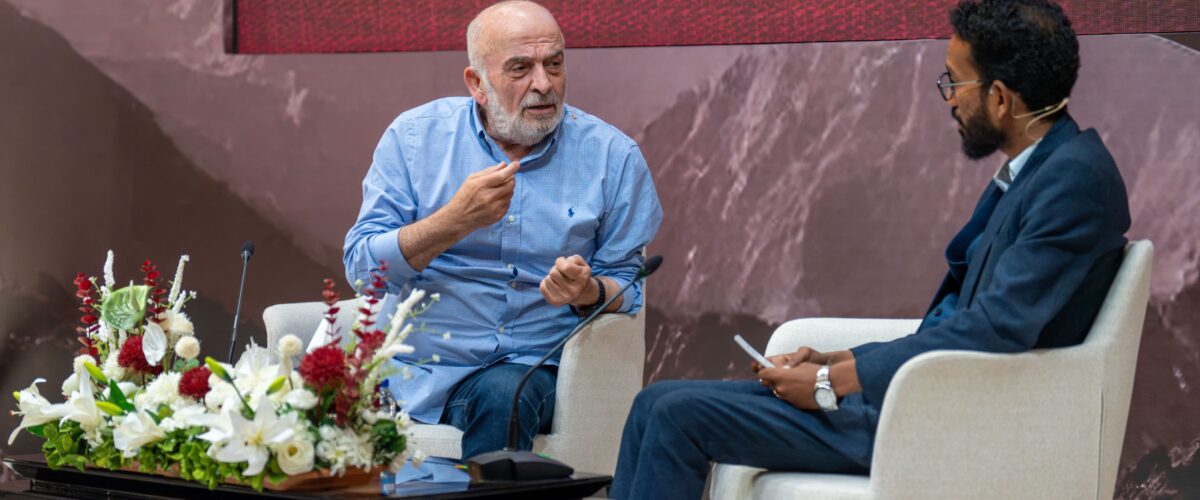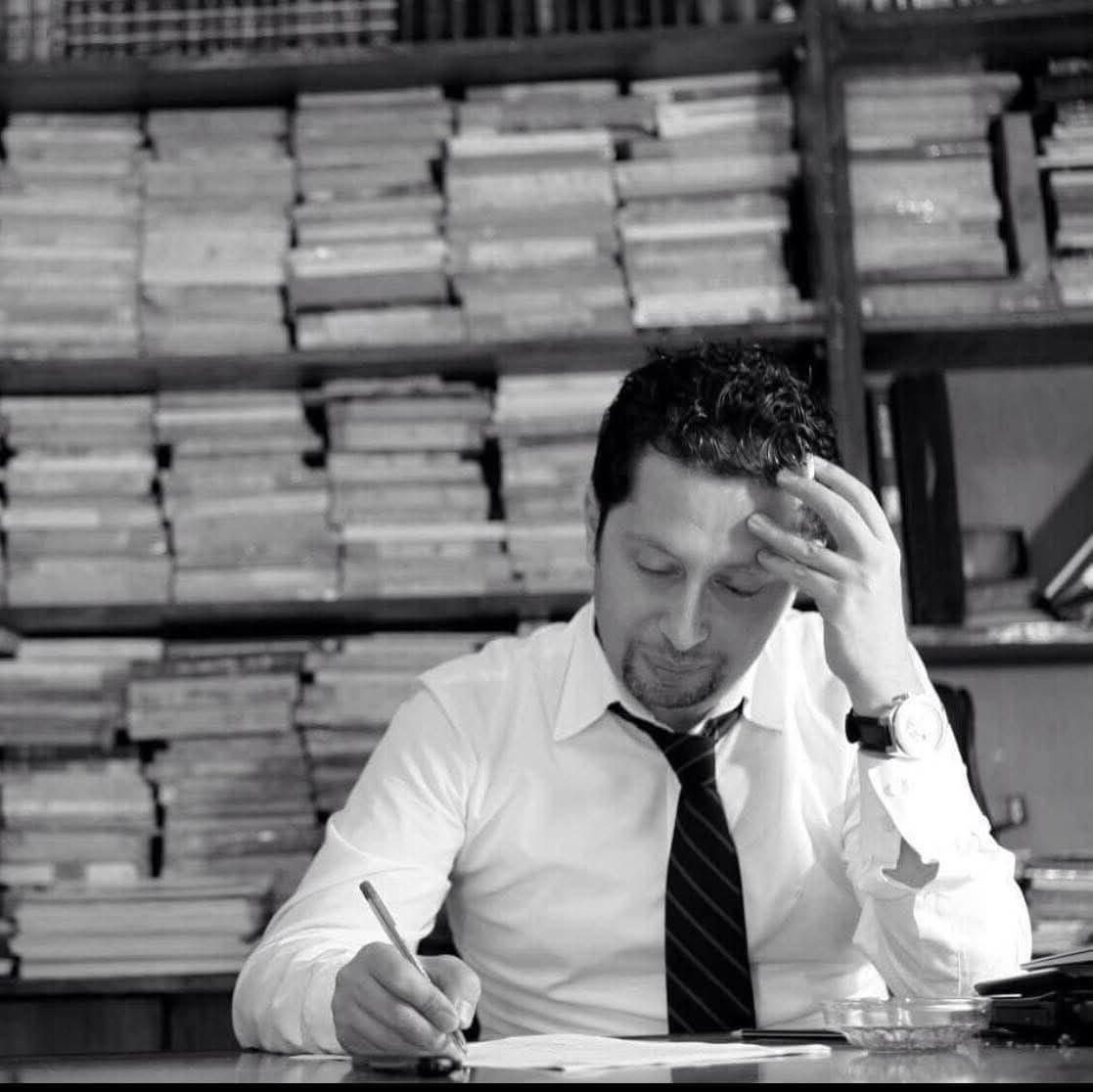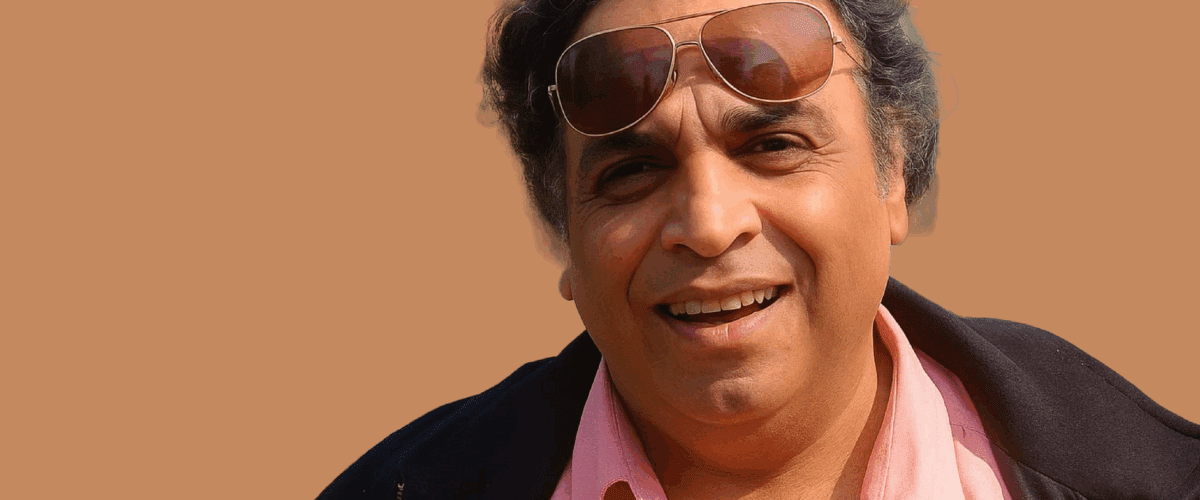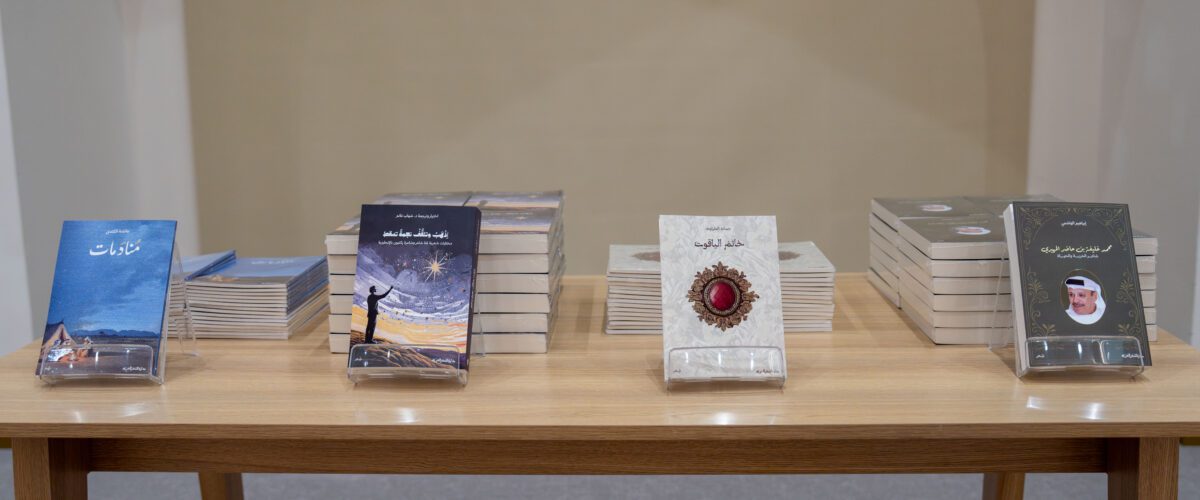أسئلة الغابة: أزمة الشعر النسوي! | د. حنين عمر

د. حنين عمر
شاعرة وكاتبة جزائرية
كما تنمو الغابات الاستوائية المعتمة، تنمو تلك الأسئلة الصَّامتة التي يعرفها الجميع ولا يقولها أحد، وتتمدد أغصانها الشَّائكة لتتشابك مع الحقيقة وتجرح كلَّ من يمد يده إليها، وكأنها تلوِّح بمخاطرة التَّوغل والكشف، ومجازفة البحثِ عن إجابات مجهولة، غير أن نظرة واحدة على المشهد –متى ما اقترنت ببعض الوعي- كافية لاستيعاب أهميَّة أن نتساءل، وأن نبحث، وأن نحاول فهم مختلف الظواهر الموازية للعملية الإبداعية.
ولعلَّ من أكثر الأسئلة التي يتم تفادي الحديث عنها نقديًّا، هي أزمة الشِّعر النسوي –مع تحفظي على المصطلح واضطراري لاستخدامه- ففي حين تعج المدونة النقدية بكثير من الأسماء الشعرية المؤنثة، التي غالبًا ما يتم تفخيم كثيرٍ مِنها من باب المجاملة أو التعاطف، إلا أن تلك القراءات تحتفي غالبًا بتجارب معينة لأسباب معينة، وتغفل أخرى –لأسباب أخرى- سهوًا أو عمدًا، لكنَّها نادرًا ما تغامر بطرح الظواهر المسكوت عنها علنًا، والمُتهامَس حولها سرًّا، والمرتبطة بهذه الفئة الإبداعية. فما هي هذه الظَواهر؟ وما هي هذه الأزمة؟ وما هي هذه الأكَمَة التي لا بد من استقراءِ ما وراءها؟
سأعود في البدء بالذاكرة إلى سنوات بعيدة كنت فيها ما أزال في بداية تجربتي، حينما انتبهت بالمصادفة إلى افتتاحية مجلة ثقافية قديمة، كانت تحتل صدارتها مجموعة من كبار الأدباء والنقاد، أولئك الذين رُتِّبَت صورهم بعناية في أولى صفحاتها، باعتبارهم الأهم والأشهر والأفضل –وقد كانوا كذلك– إلا أنني تساءلت ببراءة يومها: لماذا لا توجد أي صورة نسائية بينهم؟ وكان هذا سؤالًا أشبه بكرة ثلج راحت تتدحرج في وعي فتاة في عشرينياتها وتكبر شيئًا فشيئًا، وتكشَّف لها أنَّ تطابُقَ جينين وراثيين في حمضها النووي، قد يحدد –رغم اجتهادها- مصيرها الشعري المحتَّم.
ولا أنفي هنا أن المجلة العريقة كانت ثريَّة بالمشاركات النِّسائية، غير أن الصُّورة التي كنتُ أبحث عنها لم تكن ضمن القائمة العاديَّة فيها، بل كنت أبحث –وما زلت- عن أسماء نسائية رائدة، تُصَنَّف –ويرجى الانتباه هنا-: مع الجواهري ومحمود درويش وأمل دنقل والفيتوري ونزار قباني وأحمد شوقي و مع أبي تمام وامرئ القيس والمتنبي والقائمة المخيفة تطول…! فلماذا لا يوجد مثلًا مدرسة شعرية نسائية مؤثرة تاريخيًّا في الأجيال اللاحقة؟ ماذا حدث لكثير من التَّجارب التي خفتت بإرادتها، أوتم التعتيم عليها رغمًا عنها؟ ولماذا هناك تقليل من شأن الإبداع النسائي؟ سواء بالإجحاف أو المبالغة، وقبل أن يتم اتهامي بمعاداة الذكورية، وانحيازي للأنثوية، فإنني أحرص أن أؤكد هنا –بشكل قاطع- على كوني حيادية تمامًا في قراءة الظاهرة، وأحمِّل كل ذي حِمْلٍ حِمْلَه، بل قد أذهب أبعد… إلى رفع الظلم عن الرجال الذين لطالما اتُّهِموا بأنهم وحدهم السبب، كوني أؤمن بمقولة مارتن لوثر كينغ: “لا أحد يستطيع أن يقف فوق ظهرك إلا إنْ كنتَ منحنيًا”، وما هدفي في النهاية –ككل من دخلوا غابة الأسئلة- سوى أن أدخل جحيم الوعي، ما دمت غير مرتاحة في جنة الجهل، وما دمت أرى في المعرفة خلاصًا لعقل الإنسان.
ثمَّ لنعد إلى البدايات –سريعًا- وإلى المعطيات التاريخية عن الشعر النسوي، وهو مصطلح سنتفق لأسباب لوجستية على استخدامه في ما يلي، للإشارة إلى (نصوص شعرية تكتبها النساء)، ففي حضارة بلاد ما بين النهرين، يبرز اسم أقدم شاعر معروف على الأرض –ولم أقل هنا “شاعرة” لتأكيد السبق على الجنسين– وهي إنهيدوانا ابنة الملك سرجون الأكدي، وقد ولدت عام 2286 قبل الميلاد، وتوفيت وهي بعد شابة في الخامسة والثلاثين، لكنها خلال حياتها القصيرة، تركت أثرًا عظيمًا وكتبت نصوصًا خالدة، اتخذت شكلًا خارجيًّا دينيًّا، لكنَّ تأمُّلَ معانيها وصورها وإحالاتها، يُفضي إلى كونها مجرد قناع، أخفَتْ الشاعرة خلفَهُ رؤاها الذاتية، وقصَّتها المأساوية بإسقاطات بارعة، ومع ذلك لم تحظَ نصوصُها للأسف بالاحتفاء نفسه الذي حظيَتْ به ملحمة جلجامش، ولم تترجم أعمالها إلا فيما ندُر، ومثلها أيضًا كثير من الشاعرات اليونانيات كإيرينا ونوسيس وكورينا، والشاعرات الأوروبيات المهمات اللواتي تمَّ التَّعتيم عليهن في مسارات التَّرجمة العربية، فلم تصل منهن سوى أسماء قليلة، أغلبها ليست بأهمية من تمَّ إغفالهن لأسباب إديولوجية!
أما على المستوى العربي، ففي العصر الجاهلي، تظهر أسماء كثيرة جدًّا فُقِدَ أغلبُ أثرها النصِّي ولم يتبقَّ منه سوى أبيات متناثرة، مثل صفية الشيبانية، الشخصية القوية الشجاعة، التي –لسبب مجهول- يُغْفِل كثيرٌ من الدارسين أهميتها السياسية، ولم يُحفَظْ من شعرِها إلا ما ارتبط بمعركة ذي قار، والتي تم تحجيم دورها الكبير فيها، أما أشهرهن وهي الخنساء، فرغم شهرتها الواسعة لم تنل ما ناله مجايلوها من الرجال، كما أن قصتها مع النابغة الذبياني، وإلقاؤها عليه قصيدة في رثاء صخر ليمنحها صكَّ التفوق، فلا يمكن أن تصح ببساطة لأن النابغة الذبياني توفي عام 604م، في حين توفي صخر عام 613م، أي بعد النابغة، فإما أن تكون القصة غير صحيحة، وإما أن يكون النص الذي ألقته مختلفًا، وهو ما يعني أنَّها لم تكن بعد قد اشتهرت ونضجت تجربتها. ولا بد أن نشير هنا إلى معلومة خاطئة حول وفاة أبنائها الأربعة، فالخنساء “السلمية” ليست من مات أبناؤها، إنما “النخعية” -كما أورد الطبري- إضافة إلى أن ابنها الشاعر الشهير عباس بن مرداس توفي بعد معركة القادسية، وابنها الثاني “هارون” توفي أيام الجاهلية في حادثة ثأر.
ولا بد من أن نشير لشيء مهم هنا، وهو ظاهرة الرثاء في العصر الجاهلي، وارتباطه بالمرأة تحديدًا، والذي يعود – برأيي- ببساطة إلى كون المرأة في ذلك الوقت المحفوف بالحروب والنزاعات وقسوة الحياة… كانت لا تصل إلى سن النضج الشعري، إلا وقد تيتَّمت أو ترمَّلت أو أثكلت أو فقدت أخًا… فتشرَّبت بذلك من فلسفة الموت، وأصبحت ترى الحياة عبره، وباتت قصائدها انعكاسًا له، وتعبيرًا عن آلامها الوجودية.
غير أن ذلك لم يكن كافيًا لتُذكَر أي شاعرة في كتاب “المفضليات” مثلًا – الذي كُتِبَ بين 764م و787م، ويعتبر من أول المدوَّنات التي حفِظَتْ إرث العرب الشعري، والذي ضمَّ 67 شاعرًا وقرابة 130 نصًّا، بغياب تام للشعر النسائي، أما كتاب “الأصمعيات” فذُكِرَتْ فيه –ويا للسعادة- شاعرة واحدة فقط هي سُعْدَى بنت الشمردل الجهنية، بقصيدة واحدة من ضمن باقة ضمَّت قرابة 92 نصًّا، ويبدو اسمها أصلًا خيارًا غريبًا، إذ لم تكن من الشاعرات المشهورات مقارنةً بغيرها ممن لم تُذكرن كالخنساء وصفية الشيبانية وهند بنت النعمان، وكان لا بد من انتظار “ديوان الحماسة” لصاحبه الشاعر الشهير أبو تمَّام، ليذكر بعض الشاعرات مثل السلكة أم السليك، وعمرة بنت مرداس، أما “كتاب الحماسة” للبحتري، فخصَّص بابًا لمراثي النساء آخر مؤلَّفِه، وحُقَّ لنا أن نتساءل عن سبب كل ما سبق؟ مثلما حُقَّ لنا أن نتساءل عن سبب كون كل المعلقات قد كتبها شعراء رجال!
أما بدخول العصور الأموية والعباسية وحتى الأندلسية، فقد طرأت تحوُّلات على الحياة الاجتماعية والبيئة الأدبية، وأصبح الشعر النسائي مربوطًا بشكل كبير بالجواري اللواتي كُنَّ يستخدِمْنَهُ كحرية تعبير وأداة تميُّز، فتكونت ظواهر شعرية جديدة، تبدو فيها النصوص أكثر غزارة صوريًّا، وأكثر جرأة موضوعيًّا، ولكنها لم تستطع – للأسف- أن تفرز عدالة من أي نوع بين الجنسين، بل كرَّسَتْ صورة نمطية تضرُّ أكثر مما تنفع، وتسبب ذلك في تبلور صورة ثانوية عن المرأة الشاعرة.
وأخيرًا، وفي العصر الحديث، لم تتغيَّر الأمور كثيرًا، إذ ظلَّ الشعر النسائي مستبعدًا من الخطوط الأمامية التي رابط عليها شعراء كبار لا يمكن إلا الاعتراف بأهمية تجاربهم واستحقاقهم بجدارة، وبالمقابل لا يمكن أن نتذكر في مواقع الريادة سوى أسماء قليلة، أهمها نازك الملائكة، التي حاولت أن تفتح بابًا لإثبات قدرات المرأة الشاعرة ليس فقط شعريًّا إنما نقديًّا أيضًا، وقد كان من الممكن أن يتحقق ذلك مع الانفتاح واتساع مساحة الحرية التي نالتها النساء في العقود الأخيرة، والتي دحضت حجة القمع الذكوري والسلطة الاجتماعية، باعتبارها الشماعة التي يتم تعليق أسباب الأزمة عليها، لكن العكس هو ما حدث، إذ علا صوت الجعجعة، وغاب الطحين، وكثُرَتْ الشاعرات وقلَّ الشعر، وبدل أن تتصدَّر المشهد أسماء كبيرة تُغَيِّر النظرة النمطية التي تم سَجْنُه فيها، تراجعت سلطة النقد أيضًا، ومنح بعضُهُ شرعيةً لكثير من المواهب المحدودة، من مبدأ التشجيع أو التلميع، في مقابل تحجيم المواهب المميزة، وحصارها أحيانًا ومحاربتها أحيانًا أخرى، بسبب تفشي الظواهر السلبية بشكل أكبر مع دخول عصر وسائل التواصل الاجتماعي التي ضيَّعت مشية الغراب.
وإنني لا أحاول هنا أن أُدينَ المشهد المُدان، والذي نعرف جميعًا ما له وما عليه، بقدر ما أحاول أن أشير إلى موضع الداء لنجد الدواء، فإيجاد حلٍّ يستدعي الاعتراف أولًا بوجود مشكلة كبيرة وواضحة، تتفاقم عبر العصور، وتعطل تطور الشعر العربي وتؤدي إلى إهدار المواهب وتحطيم التجارب، لذا وجب علينا تحليل الظاهرة بشكل أكثر عقلانية، بعيدًا عن الخلافات، ودون أن ننكر وجودها وخطرها، ودون أن يُلقي كل طرف اللوم على الآخر بلا جدوى، وأن نفهم أن الأزمة حاليًا تتجاوز قيمة النص، وجدية الموهبة، وتصل عميقًا إلى مفهوم التلقي، وحيادية النقد، وإعادة إنتاج الوعي وبناء الإنسان، ولن يكون هذا إلا إذا قررنا أن نتوقَّف عن التساؤل بصوت خائف، وقررنا أن ندخل تلك الغابة المعتمة بشجاعة، وأن نقلم أشجارها ونرعى أزهارها، ونُعَبِّد طرقاتها، لنسير بأمان إلى ما بعدها، إلى هناك… إلى قمة التاريخ!