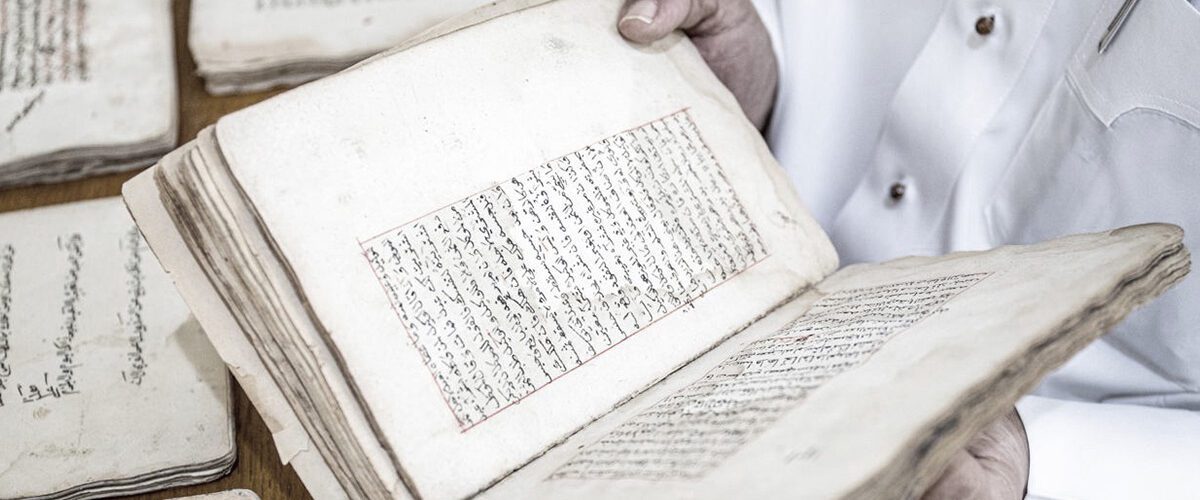الإِصغَاءُ للمُمكِنِ في الوَتَرِ المَقطُوعِ | موزة عبدالله العبدولي

موزة عبدالله العبدولي
ناقدة من الإمارات
تطمحُ هذه المقالة الوقوف على صَدى الأصواتِ في نصِّ شاعرٍ أصم، حيثُ فَقدَ الشاعر السوريّ «رياض الصالح الحسين» (1954 – 1982) حاستي السمع والنطق وهو في الثالثة عشر من عمره إثر مرضٍ مفاجئ يُرجح أنه قصور كلويّ[1]، وظلَّ الشاعرُ يُواري مرضه عن الجَمع، مُرتاحاً في ظلاله الباردة، وناكراً علّته أمام العالم، يقول عنه الشاعر «منذر المصري»: “كان رياض يريد أن يكون صحيحاً، لا ينقصه شيء كالجميع، كامل أو شبه كامل كالجميع، وقابلاً لكل شيء، وأكثر من كل شيء”[2]، فاحتفظ الشاعرُ بذاكرة الصوت أو أشباحها، وظلَّ يستعيد الأغنيات بوصفها النغم المُستحيل.
وأمام هذه الخزينة الصوتيَّة واللغويَّة، يتبينُ لأيّ قارئ في تجربة الشاعر: بساطة الألفاظ والصور والتراكيب ومحدوديَّة المُفردات، إذ تقوم قصائده على معجمهِ المُحاط بمهمومه، كنداءات الوَطن في ثوراته وحريَّاته، أو بكائهِ على هجرِ الحبيبة، ووحشة الوحدة، أو سخطه على قُبح العالم، ونستدلُّ بذلك أنّ الصُّم يمتازون بذخيرةٍ لغويَّة محدودة، وتتمركزُ ألفاظهم حول الملموس، وتظهر جملهم بشكلٍ أقصر وأقلّ تعقيداً[3]، وهذا الذي يتضح في تجربةِ الصالح، لكن معجمه يُعدُّ مُعجماً مُتطوراً ومُتشرّباً من التجربة الشعريَّة العربيَّة، وهو معجمٌ له حدوده اللغويَّة التي تعكس عالمه الشعريّ المسوَّر. في حين لا بُدَّ من آثارٍ تنعكس على تكوّن قصيدته بفعل الصمت الجبريّ الذي تعيشه ذاته الشاعرة، إذ يُفسر العالم الأنثروبولوجيّ «ديفيد لوبروتون» فجوة الصَّمت في قوله:”إنَّ عشيرة المعنى في شقها الأكبر عشيرة صوتيّة، وانفتاحٌ على صخب الحياة اليومية (..) الصممُ يُعدمُ بُعداً مُمكناً للواقع.”[4]
يعبرُ الصوتُ جسورَ التواصلِ مع الذاتِ والعالمِ والذاكرة، فتتمحورُ الأغنية في القصائد بوصفها الجوهر المفقود بعدَ جُرحِ الصَّمم، والحنين للصوتِ الجميلِ وطربهِ، لتجيء الأُغنيات في القصائد مؤسسةً جسرَ التواصلِ إلى عالم الأمس، أو حُلم الغد البعيد، وتظهر بوصفها الأمل والعلاج والسلام للحاضر البائس، يقول في ذلك:
“كنتُ أوزع الحب في القلوب
كما يوزعون الرصاص
كنتُ أنثر الأغاني في الطرق الجبلية
كما ينثرون الأنغام”[5]
فالأغنيات هي مفردات الحب واللحظات السعيدة أمام بؤس الحروب ودمويتها، إذ يتضح أن أضداد الأغنية في معجم الشاعر هي الحروب وأسلحتها، وتتأكد هذه الثنائية في قوله للشاعر نزيه أبو عفش: “وإنك لكذلك / قريب كالحروب / وبعيد كالأغاني”[6]. لتخلق بذلك هذه المفردات هالتها الدلاليَّة كالسلب والإبادة والفناء (الحروب) والعطاء والنمو والديمومة (الأغاني). وقد ظلَّت مُفردة الأغنيات تظهر في القصائد محمّلةً بمعاني النور والأمل، وهي بكل أصدائها تُصارع القسوة والموت:
“هل تذهبين إلى العشب؟
أم تذهبين إلى الحرب؟
كنا نسير وتثقبنا الطلقات
وكنا نسير نسير بدائرة قطرها ألف حزن
يداً بيد ونغني
يداً بيد ونموت”[7]
إنَّ مشهد النهاية في الذهاب إلى الموتِ غناءً؛ يعكس صورةً من صور المُقاومةِ بسلاح الصوت الطروب، إذ تتحد في هذه النهاية المثاليَّة قوتان: قوة الموت وقوة الغناء. وتكمن الغرابة المُستمرَّة في استمساك الشاعر بسلاح الأغاني، السلاح الصوتيّ الذي لا يملك ذخائره، وهو يستمر بتوكيداته لهذا الحرمان من خلال تشبيه نفسه بقاعدة تُطلق الأغاني، يقول مخاطباً الحبيبة:
“ألا أبدو لكِ كقاعدة أرضية لإطلاق الأغاني على البشر فلماذا تنظرين إلي ببلاهة؟”[8]
إن افترضنا أن أغنية الشاعر قصيدته، فهي قصيدة الأمل والحب التي تُضيء، ليكون هو الصوت الذي لا يستطيع قوله، لكنه يصل للبشرية جمعاء، وفي هذا التصوّر المثاليّ لما تخلقهُ الأغنياتُ من أثرٍ مُشرقٍ؛ تظهرُ في العديد من المشاهد بوصفها المهدئ والمُعالج، كقوله: “من سيغني لي أغنيةً في المساء لأنام / إذا وضعوا بين جفني صخرة مدبّبة؟”[9]، فتهويدات الطفولة – أو الحنين إلى تلك المرحلة الصوتيَّة – هي أقصى ما يرجوه المؤرَّق لإخماد أرقِهِ، لكنَّها أغنيات لا تصل، وسلوى يستحيل تحقيقها. في حين تلحُّ الأغنيات في معجمهِ، لتؤكّد معاني الأمان والحب والخير، فها هي يد الحبيبة التي تنطلق منها الأغنيات:
“لا تفتحي يدَكِ..لا تفتحي يدَكِ
فكلُّ أغاني العالم ستنطلقُ منها
لا تغلقي يدَكِ.. لا تغلقي يدَكِ
فكلُّ أغاني العالم ستلتجئ إليها”[10]
إذ طالما ما ارتبطت اليد بالعطاء والاستقبال، وهي هنا في كلتا الحالتين تستقبلُ الأغنيات وتُطلِقها، تحتويها وفي الآن نفسهِ تمنحها الخَلاص، فقد صارت الأغنياتُ قرينة المُعجِزة، بكلِّ هذه المُستحيلات التي تنبثقُ من خلالها. وتصطفُّ الأغنيةُ بجانبِ النهر وصفائه، والنهار وبهائه، لتكون مكوّناً طبيعياً يُحسِّن من جودة الحياة، ويرتقي بالمرء إلى سَلامِه المأمول، يقول:
“أمامي الكثير لأعطيه
وخلفي الكثير للمقابر
أمامي النهر ورائحة الصباح والأغاني”[11]
لكن هذه الأغنيات التي أصبحت رمزاً للجمال، يحلُّ بغيابها قَسوَة الوَحشة:
“فتحتُ النوافذ
لم يدخلها أحد
لا نهر، لا فراشة، لا أغنية تائهة”[12]
أو في قوله:
“لقد بدأنا نعرف ما معنى الزمن
عندما نعود إلى البيت وحيدين
متشابكي القلوب والأصابع
بدأنا نعرف ما تعني الصخور النائمة في البحر
الشمس النائمة في السماء
والأغاني النائمة في المقبرة”[13]
وأمام سوداويَّة المعنى الذي يتحقق بغياب الأغنيات، نستجلي قيمة حضورها. فنوم الشمسِ يعني غياب الضوء، ونوم الأغنيات يعني غياب الأُنس والأَمان، وعلى الرغم من بساطةِ التشبيهات؛ إلا أنّ النصوص تصدحُ بمعاني فسيحة في وصفِ الحالة الوجوديَّة والإدراكيَّة للعالم ومكوناته، إذ أصبحت الأغنياتُ مادةً ملموسةً يتحققُ بها الوجود والمعنى.
وعند فجوةِ الصَّمتِ الكبير، وافتقاد الشاعر لنغمة الأغنيات، تجيء قصائدهُ بِتكراراتٍ لافِتةٍ تولِّد إيقاعاً موسيقياً، يقول:
“السفر.. السفر.. السفر
هو ما أريد
الحرية.. الحرية.. الحرية
هي ما أطلب”[14]
يجيء التكرارُ مُحمَّلاً بمدولاته الدلاليَّة، والصوتيَّة، فهو يُطالب، ويُشاكس ويَثور في سياقات مُختلفة، يقول: “بين يديك أيها العالم / أدور أدور أدور/ كدواليب الحظ”[15] وقوله: “أن أرقص وأرقص وأرقص / حتى تتعب الموسيقى”[16] ويجيء التكرارُ بوصفه إلحاحاً طفولياً: “ولكن قُل لي: هل تحبني؟ هل تحبني؟ هل تحبني؟”[17] أو كقوله مُخاطباً العالم: “وأقول تعال/ قبّلني قبّلني قبّلني/ قبّلني قبّلني قبّلني”[18]، ليخلق الشاعر بكلِّ هذه التكرارات الانفعاليَّة أغنيته التي يحلم بسماعها.
وإن أعدنا التنقيب في بُعدِ الأغنياتِ في التجربةِ؛ سنجدها ممثلةً الحُلم المُستَحيل، الذي لشدَّةِ استحالتهِ تستمسكُ به النَّفسُ، وتعقِدُ عليه آمالها في السَّلام والحبِّ والشفاء والأُنس، إذ صارت الأغنياتُ – أو القصائد – هي مُعجِزة الشَّاعر الأصم، الذي يُبددُ كينونته الشعريَّة في نغمتها المُمكنة.
[1] إينانة الصالح، رياض الصالح الحسين وشِعريّة التفاصيل، مجلة العربي، الكويت، ع 699: https://alarabi.nccal.gov.kw/Home/Article/18971
[2] رياض الصالح الحسين، الأعمال الكاملة (1954 – 1982)، دار منشورات المتوسط، إيطاليا، ط2، 2021م، ص:8 (مقدمة الأعمال بقلم منذر المصري).
[3] يُنظر: تعليم الصم وضعاف السمع، جمال الخطيب، الشروق، الأردن، ط1، 2021م، ص:81
[4] دافيد لوبروطون، أنثروبولوجيا الحواس: العالم بمذاقات حسيّة، ترجمة: فريد الزاهي، المركز الثقافي للكتاب، الدار البيضاء، المغرب، ط، 2020م، ص: 180
[5] الحسين، الأعمال الكاملة، ص: 87
[6] الأعمال الكاملة، ص: 125
[7] الأعمال الكاملة، ص:83
[8] الأعمال الكاملة، ص: 106
[9] الأعمال الكاملة، ص: 144
[10] الأعمال الكاملة، ص: 244
[11] الأعمال الكاملة، ص: 205
[12] الأعمال الكاملة، ص: 224
[13] الأعمال الكاملة، ص: 165
[14] الأعمال الكاملة، ص: 173
[15] الأعمال الكاملة، ص: 176
[16] الأعمال الكاملة، ص: 173
[17] الأعمال الكاملة، ص: 32
[18] الأعمال الكاملة، ص: 175