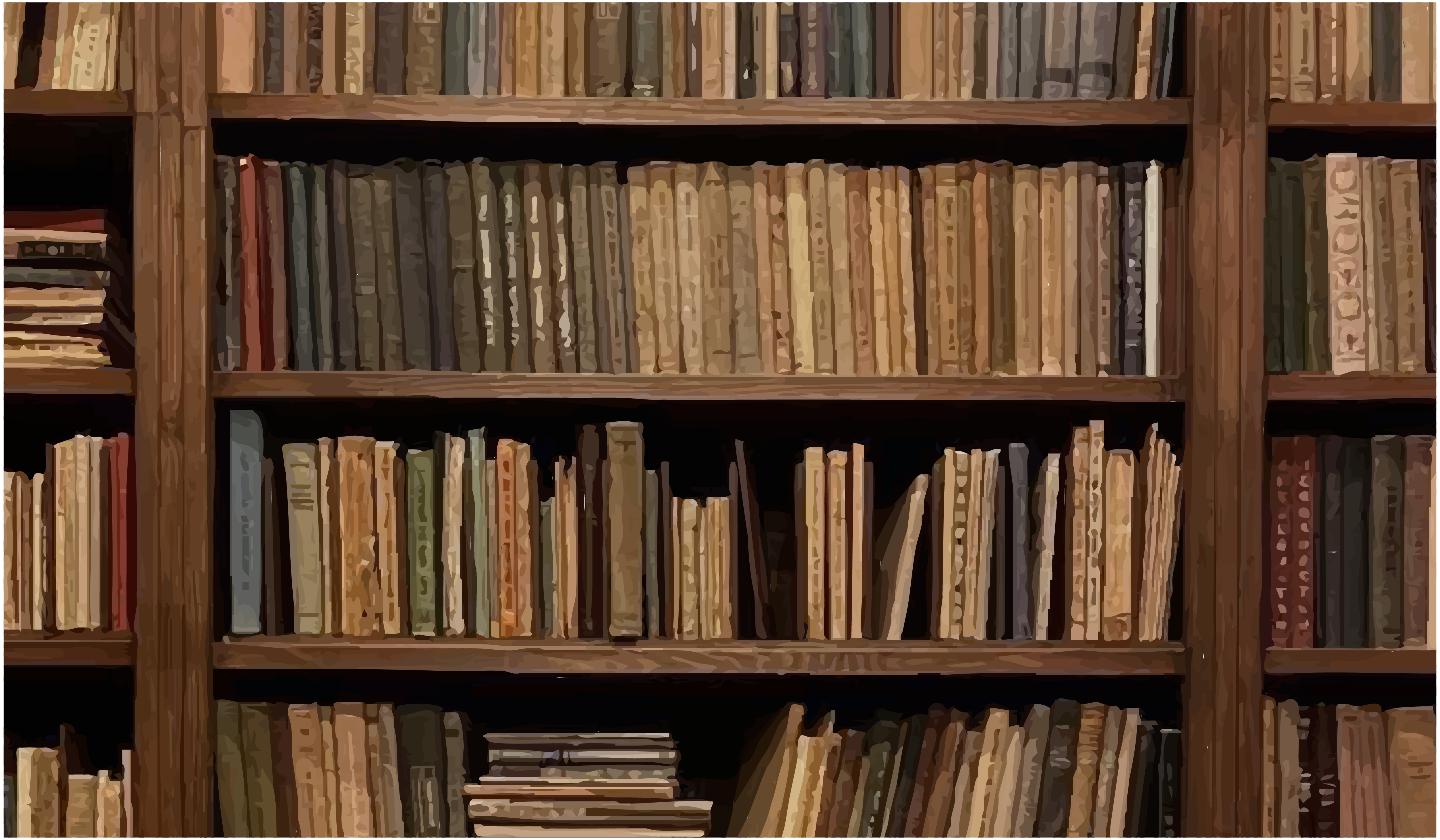عبد الرحمن الطويل
شاعر وباحث مصري
ما الذي يجعل قصيدةً ما صالحةً للغناء أكثر مِن غيرها؟ خطر ببالي هذا السؤال وأنا أرى احتفاء المطربين برائية أبي فراس الحمداني الشهيرة (أراكَ عصيَّ الدمع) منذ مطلع القرن العشرين، فمنذ ذلك الحين وصلتنا تسجيلات مختلفة للقصيدة بأصوات عبد الحي حلمي وصالح عبد الحي وأم كلثوم -التي غنتها بثلاثة ألحان- وأيوب طارش ومحمد عبده وغيرهم. فما الإكسير الكامن في (أراك عصيَّ الدمع) الذي جعلها حاضرةً أبدًا على حناجر المُغنّين؟
لسنا بحاجة إلى مجاملة أبي فراس أو مطربي القصيدة لنقول إنها مِن عيون قصائد العشق في التراث العربي، وقد تضافرت فيها ذِلَّةُ العشق مع ذِلَّةِ الأسْر مع عزة نفس الشاعر الفارس الأسير في سجون الروم لتُنتج لنا زفراتٍ شعريةً عزيزةَ المثال، تُطرب السامع الذي تزدحم مشاعره لتلتبس فيها محبة الشاعر بالإعجاب به بتعظيمه بالشفقة عليه بالحيرة لحيرته!
لأسباب مشابهة حظيَت بعض القصائد التراثية بالحالة نفسها مِن “شيوع الغناء”، لم يكن لها بالتأكيد مزيج (أراك عصيَّ الدمع) ومزاجها، لكنها تمتعت بأمزجة تشابهها في بعض العناصر، أهمها قوة حضورها في باب العشق وفرادة تعبيرها عنه، كقصيدة (يا ليلُ الصَّبُّ). ودخل شعر العشق الإلهي هذا المضمار بقوة، كالأبيات المنسوبة إلى رابعة العدوية وقصائد ابن الفارض، لإمكان قراءتها على الوجهين، ولأنَّ حالة الفناء الصوفي منحت أفق العشق اتِّساعًا أبديًّا غير محدودٍ بالبُعد المادي للفقد أو الألم.
كانت (أراك عصيَّ الدمع) من أشهر القصائد التراثية التي غنَّتها أم كلثوم، وقد سجلتها لأول مرة عام 1926 باللحن التراثي المنسوب إلى عبده الحامُولي، ويبدو أنَّ سلطان القصيدة ظل يُلحُّ عليها بتقديمها مرةً أخرى خلال عقود لاحقة تطور فيها شكل الأغنية وشكل الشعر المكتوب لها، فقدمتها ثانيةً عام 1941 بلحن وضعه زكريا أحمد، لم يصلنا تسجيل هذا اللحن، واستنتج بعضُ السمِّيعة من عدم تسجيله ومن انقطاع أم كلثوم المبكر عن غنائه؛ أن اللحن قد فشل تجاريًّا ولم يلقَ التجاوب الكافي من الجمهور.
لكنَّ (أراك عصي الدمع) لم تتوقف عن الإلحاح على السِّت، فقدَّمتها للمرة الثالثة في نهاية عام 1964 بلحن رياض السنباطي هذه المرة، ورغم عبقرية السنباطي في تمثيل مشاعر القصيدة وتجسيد زفرات الأمير الأسير فقد جاءت مِن أقل أعمال أم كلثوم نجاحًا وجماهيرية خلال عقد الستينيات.
بدا جليًّا أنّ بحر الطويل التام الذي كُتِبَتْ عليه (أراكَ عصيَّ الدمع) بات غريبًا على أنماط الغناء في الستينيَّات، وثقيلًا على إيقاعاته، لدرجة أنَّه مِن بين عشرة أبيات اختارتها أم كلثوم للغناء لم يُلحَّن على الإيقاع إلا ثلاثة، وجاءت سبعة أبيات مُرسلةً بلا إيقاع، وانعكس الأمر على موسيقى المقدمة والفواصل أيضًا.
في الموسم التالي قدَّم السنباطي وأم كلثوم قصيدة (الأطلال) لإبراهيم ناجي، والتي صارت أنجح أغاني أم كلثوم وأشهرها وأعلاها على عرش الخلود. كُتبت الأطلال على بحر الرَّمَل، فتى البحور المُدَلَّل في الحقبة الرومانسية، وأثيرها عند الملحنين فيما يبدو. فمع صعود التيارات الرومانسية في الشعر العربي، وخاصةً مدرسة أبولُّو في مصر، بدا بحر الرَّمَل اختيارًا إيقاعيًّا مفضَّلًا وكثير الاستعمال، وبات له من الانتشار ما كان للطويل في الجاهلية وصدر الإسلام، وانعكس هذا الانتشار على اختيارات الملحنين، فكان للرَّمَل السيادة على شهيرات القصائد العاطفية المغناة مثل (الجندول) و(الكرنك) و(كليوبترا) لعبد الوهاب، و(اذكريني) و(ذكريات) لأم كلثوم، و(اسقنيها) و(حديث عينين) و(أيها النائم) لأسمهان.
البنية المنتظمة لبحر الرمَل، الذي يتكون مِن تكرار (فاعلاتن) ثلاث مرات، يبدو أنّها منحتهُ قدرةً أكبر على الانتظام مع إيقاعات التلحين، مِن تلك البحور المركبة مختلفة التفاعيل. ورشاقة تفعيلته التي يتوسط فيها الوتد بين سببين جعلته أرهف قوامًا مِن شقيقيه (الرجَز) و(الهزَج) اللذين لم يُغرَ بهما الشعر الحديثُ كثيرًا، فبات حظ قصيدة الرمَل في الغناء أعلى مِن حظوظ قصائد البحور الأخرى طيلة الحقبة الممتدة بين ثلاثينيات القرن العشرين وستينياته.
إلى جانب هذا حظيت الأطلال بميزة أخرى، هي تنويع القوافي المُطَّرِد، حيث بُنيَتْ على مقاطع رباعية الأبيات مختلفة القوافي، هذه البنية سهَّلت على السنباطي تحويل كل مقطع إلى (كوبليه) متميز عمَّا قبله وما بعده. وتنويع القوافي ظاهرةٌ شاعت بأشكال مختلفة في الشعر الرومانسي، فرفدَت الغناء بعدد كبير من روائعه الخالدة.
حين سلطنا الضوء على رائية أبي فراس وأطلال ناجي كنا نحوِّم حول الأسباب التي تجعل قصيدةً ما جديرةً بالغناء ومرشحةً للنجاح على أصوات المغنين، وهو بحث يحتاج إلى استقصاء واسع لعدد كبير من القصائد المغناة قديمًا وحديثًا، وتوثيق ما نجح منها وما أخفق، حتى نصل إلى نتيجة نطمئن إلى صحتها وشمولها، لكننا باعتبار المثالين السابقين وكثير مما يقاربُهما من أغاني القرن العشرين نستطيع الوصول إلى أسباب عامة يرجع بعضُها إلى الشعر، فيما يرجع البعض الآخر إلى الغناء والسياق الاجتماعي.
في صدارة الأسباب المتصلة بالشعر تأتي قوة حضور القصيدة في بابها (غرضها ومعناها)، فعيون قصائد العشق والغزل كانت دومًا مرشحةً للغناء، مدعوَّةً على حناجر المغنين قديمًا وحديثًا، يشهد لهذا كثير من نصوص الأصوات التي غُنِّيَت للرشيد وتأسس عليها كتاب (الأغاني)، كما تشهد له قصائد كثيرة غُنِّيَت في العصر الحديث على اختلاف حظوظها مِن الشهرة، وهذا السبب يتجاوز موضوعات الحب والعشق إلى سائر الموضوعات التي يُمكن أن يدعو السياق الثقافي أو الاجتماعي إلى الغناء فيها، ففي باب المديح النبوي لا يمكن تجاهل موقع (البردة) و(الهمزية) للبوصيري اللتين تواتر عليهما المنشدون في جميع أقطار العالم الإسلامي، وأورثا هذه الشهرة لمُعارَضاتهما مثل (نهج البردة) لشوقي، التي اختارت أم كلثوم غناءها.
السبب الثاني المتعلق بالشعر هو مناسبةُ وزن القصيدة وقافيتها لأنماط التلحين والغناء السائدة، ولذا نجد بحر الطويل ظل متسيدًا أوزان الشعر في الجاهلية بسبب ملاءمته للحُداء. ومع ازدهار الغناء في العصرين الأموي والعباسي وتطور أنماطه على حناجر القِيان اندفع الشعراء إلى الكتابة على الأوزان القصيرة والمجزوءة في موجة واسعة بدأت مع نهاية العصر الأموي على يد الوليد بن يزيد، وبلغت ذروتها في العصر العباسي مع أبي نواس وأبي العتاهية.
وفي العصر الحديث نال بحر الرَّمَل حظًّا أعلى من غيره من البحور، بسبب انتظام إيقاعه المبني على تكرار تفعيلة واحدة يتوسطها وتدٌ بين سببين. كما كانت القصائد ذات القوافي المنوعة أسعد باختيارات الملحنين والمطربين في الغالب، لأنّ تقسيمها في البنية اللحنية أسهل.
أما السبب الثالث فالسهولة والمباشَرة التي لا تُفرط في الجودة، مِن أجل ذلك حظيت قصائد نزار قباني بحضور قوي على حناجر كثير من المغنين والمغنيات في عدة بلدان عربية، لأنها حققت معادلة ليست سهلة على الجميع، إذ ضمنَت إقبال الجمهور دون تفريط في المستوى اللغوي والثقافي، وهذا جعلها اختيارًا رابحًا من الوجهتين الثقافية والتجارية معًا.
أما الأسباب غير المتصلة بالشعر فقد ترجع إلى علاقات الشاعر بأهل الغناء، فدائمًا حظيَ الشعراء الذين كوَّنوا صداقات متينة مع الملحنين والمغنين بغناء قصائدهم أكثر من غيرهم، فكان طبيعيًّا أن يغني عبد الوهاب عشرات القصائد من شعر شوقي الذي تبنَّاه وأسكنه بيتَهُ وكتب له خصِّيصى، ولذا كان أحمد رامي من أكثر شعراء الفصحى انتشارًا على حناجر المغنين لأنه كان صديقًا لمُعظم ملحني عصره ومطربيه، فضلًا عن رعايته الخاصة لأم كلثوم التي اعتمدت عليه بشكل كلي في عقودها الأولى، والأمر نفسه مع سعيد عقل وصداقته المتينة مع الرحابنة وفيروز. هذه الصداقة تجعل قصائد الشاعر أقرب إلى أنظار الملحنين وأسرع وصولًا، كما أنها صاحبة فضل في ميلاد كثير من القصائد التي يطلبونها مِنه لمشاريعهم الغنائية.
ومِن هذه الأسباب أيضًا ثقافة المغني وإقباله على غناء قصائد قد لا تكون شهيرة أو رائجة لدى العامة، وشكل الغناء الذي يؤديه، فالمغنّون الذين يمارسون أشكالًا مِن الغناء المرسل (الذي لا يصاحبه إيقاع) سواء كان بصحبة العود فقط، أو في شكل الموّال في بداية الوصلات الغنائية أو وسطها، هؤلاء أقدر على غناء قصائد تراثية أكثر، ومن مختلف البحور، لأنّ غناءهم غير مقيد بإيقاع مصاحب، وفي مثل هذه الأشكال سمعنا (أقول وقد ناحت بقربي حمامة) من ناظم الغزالي وطلال مداح، و(ما لنا كلنا جَوٍ يا رسولُ) من وديع الصافي.
وأخيرًا يأتي السياق السياسي والاجتماعي الذي قد يفرض غناء قصائد لمناسبات بعينها، ثم يكون حظها بعدُ من الخلود أو النسيان بقدر ما أحسنَ صانعوها.