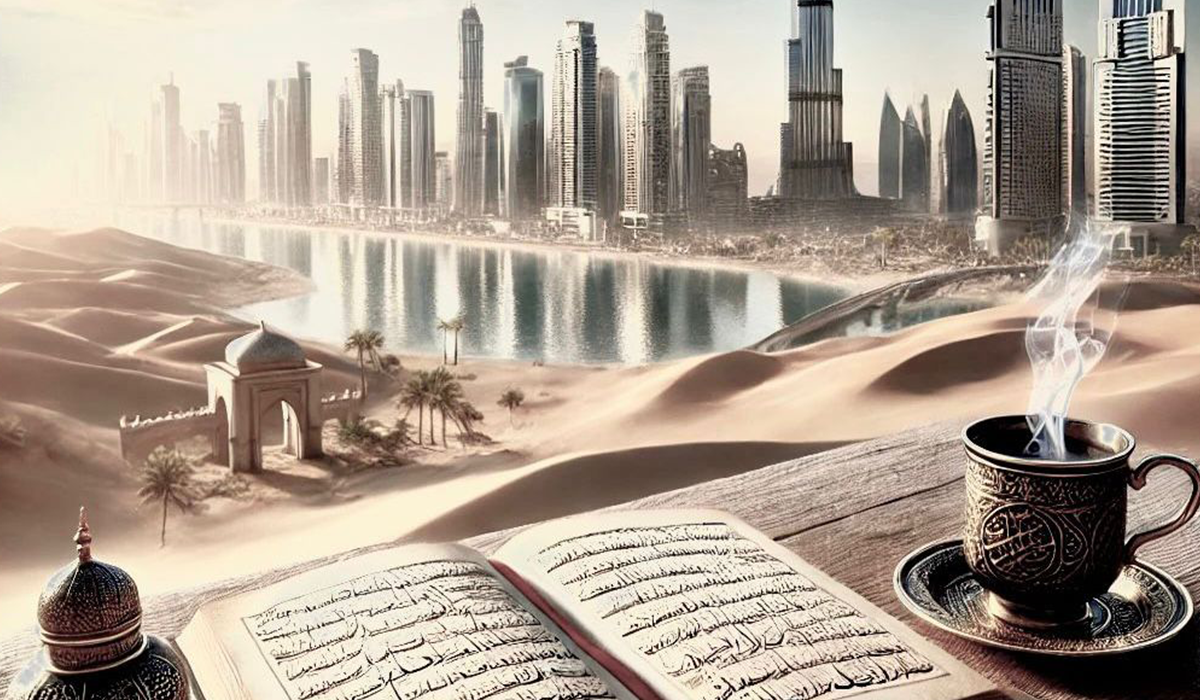عادل خزام
شاعر/ الإمارات العربية المتحدة
لا يُمكن على وجه الدِّقَّةِ الوقوف على توثيقِ تجربةِ الحداثةِ الشِّعريةِ في الإمارات، وتحديدًا إرهاصاتِ ظهورِ قصيدةِ النثرِ أو مَن بدأ بها أولًا. لكننا نملكُ مجموعةً من المعطياتِ التي أسَّستْ لظهورِ هذه التجربةِ الشِّعرية، والتي تصاعدتْ بشكلٍ كبيرٍ منذ مطالعِ الثمانينيات لتصبحَ إحدى التجاربِ المهمةِ في منطقةِ الخليج، كونها ضمَّت مجموعةً رائعةً من الأصواتِ الشِّعريةِ الشابةِ التي أنجزتْ نصًّا شعريًّا متجاوزًا يرتقي إلى مستوى التجربةِ العربيةِ التي سبقته في بلدانِ الشامِ والعراقِ ومصرَ والمغربِ العربي.
الإرهاصات الأولى
من وجهةِ نظري كشاهدٍ على هذه التجربة، فإنَّ التمهيدَ لظهورِ قصيدةِ النثرِ بدأ مع تجربةِ الشاعرِ د. أحمد أمين المدني، الذي درسَ في العراقِ وعادَ منها في أوائلِ الستينياتِ متأثرًا بموجةِ التجديدِ وشعرِ التفعيلةِ الذي ظهرَ في العراقِ على يدِ نازك الملائكة، ثم تطوَّرَ بعمقٍ في تجاربِ بدر شاكر السيَّاب وعبد الوهاب البياتي وآخرين. كتبَ المدني شعرَ التفعيلةِ مقدِّمًا لأولِ مرةٍ تجربةَ كسرِ البيتِ الشِّعريِّ الكلاسيكيِّ، وكان ينبغي لتجربتهِ هذه أن تتطورَ بعدَ أن درسَ في جامعةِ كامبريدج ببريطانيا ثم السوربون في فرنسا، حيثُ الحداثةُ وقصيدةُ النثرِ هناك عمرها أكثرُ من مئتي عام. لكن مع ذلك، حافظَ المدني على كلاسيكيتهِ العربيةِ وقدمَ شعرهُ العموديَّ وقصائدَ التفعيلةِ معًا في ثلاثِ مجموعاتٍ هي: حصاد السنين 1968، أشرعة وأمواج 1973، عاشق لأنفاس الرياحين 1990. وربما أشارت بعضُ الدراساتِ إلى أنَّ هناكَ بعضَ الأسماءِ التي ربما سبقتِ المدني في تجريبِ شعرِ التفعيلة، لكنها لم تكتملْ ولم تتأسسْ على نضجٍ كافٍ لترسيخها في سياقِ دراسةِ الأدبِ الإماراتيِّ وتحولاتهِ الفنيةِ والموضوعيةِ والفكرية. لكن يمكن الرجوعُ إليها في البحوثِ والدراساتِ التي قدمها الأستاذُ بلال البدور، وجمع فيها قصاصاتٍ وقصائدَ مفردةً ومحاولاتٍ أولى لشعراءَ من الإمارات لم تكتملْ تجاربُهم لاحقًا. حيث الى جانب الأسماء الراسخة، ذهب البدور عميقاً للبحث عن الذين حاولوا كتابة الشعر ولم يكملوا الطريق. وفي كتابه النوعي (موسوعة شعراء الإمارات – الجزء الأول) قدم لنا تراجم لـ 101 من شعراء الفصحى الذين كتبوا الشعر العمودي.
التحولات الاجتماعية السريعة
كانتِ الساحةُ الشِّعريةُ في الإماراتِ تقومُ على القصائدِ الكلاسيكيةِ بالطبع، وكان المجتمعُ التقليديُّ لا يستسيغُ هذه النقلةَ في كسرِ البيتِ الخليليِّ، لكن مع قيامِ دولةِ الإماراتِ الثاني من ديسمبر من العام 1971، أصبحَ التحولُ نحو الحداثةِ سريعًا جدًا وشملَ جميعَ القطاعاتِ وتحديدًا التعليمَ، حيثُ دخلتْ في وجدانِ الإنسانِ الإماراتيِّ روحٌ جديدةٌ وارتفعَ في داخلهِ الشغفُ والطموحُ للارتقاءِ في كلِّ شيءٍ بما فيها الفنونُ والآداب. وبمجردِ وصولِنا إلى أوائلِ الثمانينيات، انتظمتِ الصحفُ اليوميةُ في الصدورِ (بعدَ أن كان صدورُها متقطعًا) لتخصصَ صفحاتِها الثقافيةِ لتجاربِ التجديدِ في الوطنِ العربي. وصرنا نقرأُ ونسمعُ بأسماءِ محمود درويش والماغوط وأدونيس ونزار قباني وغيرهم من روادِ موجةِ التجديد بشكل يومي، ونتأثر بفكرهم.
ازدهار الحياة الثقافية
مع أوائلِ الثمانينياتِ أيضًا انتظمتْ معارضُ الكتبِ لدينا في الشارقةِ وأبوظبي، وجاءتْ كتبُ الشِّعرِ الجديدِ وأيضًا الشِّعرِ العالميِّ (المترجم) لتقعَ بين أيدينا نحنُ الشباب، حيث كنّا لا نزالُ طلبةً في جامعةِ الإمارات أو مبتعثينَ للدراسةِ في الخارج، وصار لزامًا أن نتأثرَ بهذه التياراتِ التي نظَّرتْ وانحازتْ أيضًا إلى قصيدةِ النثرِ، فانقسمتِ الساحةُ الشِّعريةُ إلى ثلاثِ فئاتٍ هي: روادُ القصيدةِ الكلاسيكيةِ الكبارُ من الجيلِ الأول، ثم روادُ وشبابُ قصيدةِ التفعيلةِ، ومنهم د. أحمد أمين المدني، وحبيب الصايغ، وعارف الشيخ، وعارف الخاجة، وإبراهيم الهاشمي، وكريم معتوق، وصالحة غابش، وظاعن شاهين، وأمينة ذيبان، وأسماءٌ أخرى كثيرةٌ قدمتْ نفسها لكنها لم تكملْ الطريق. ثم في هذه الفترةِ (نهاية السبعينيات حتى منتصف الثمانينيات) بدأتْ تبرزُ أصواتُ المجربينَ الخائضينَ في مغامرةِ قصيدةِ النثر، بدايةً من ظبية خميس، نجوم الغانم، أحمد راشد ثاني، ميسون صقر، خالد البدور، خالد الراشد، علي العندل، عبدالعزيز جاسم، ثاني السويدي، خلود المعلا، سالم بوجمهور، محمد المزروعي، وآخرين، وكنتُ أنا معهم نشهدُ هذه التحولاتِ السريعة. وكان معنا أيضًا كتابٌ وأدباءُ خليجيونَ وعربٌ منهم قاسم حداد وأمين صالح من منبرِ جريدةِ الخليج التي كانت تصدرُ في الإماراتِ والبحرين في نفسِ الوقت، والشاعرُ سيف الرحبي من عُمان الذي أقامَ لفترةٍ في الإماراتِ وعملَ في مجلةِ أوراق التي يصدرها حبيب الصايغ من أبوظبي. وأيضًا كان معنا الشعراءُ والمثقفونَ العرب، ومنهم محمد الماغوط الذي أشرفَ على صفحاتِ جريدةِ الخليج الثقافية واستقطبَ نصوصَنا وقدمها، والكاتبُ السودانيُّ محمود مدني، ود. يوسف عيدابي، وبعضُ الأسماءِ العربيةِ الأخرى.
وقفات لا بد منها:
أولًا: أحبُّ هنا أن أتوقفَ عند بروزِ اسمِ المرأةِ الإماراتيةِ في تجربةِ الحداثةِ منذ بدايةِ انطلاقتها نتيجةً لقوةِ التعليم، ولا زلتُ أذكرُ العشراتِ من الأسماءِ النسائيةِ التي أسَّستْ لصوتِ الحداثةِ، ليس فقط على مستوى قصيدةِ النثرِ، وإنما في القصةِ القصيرةِ والفنِّ التشكيلي، حيث امتدتْ (روحُ الحداثة) إلى الفنونِ البصريةِ، وكما نادى الشعراءُ مبكرًا بكسرِ الوزنِ الخليلي، ظهرَ من بعدِهم من ينادي بكسرِ الإطارِ التقليديِّ للوحةِ الفنيةِ مثل الفنانِ حسن شريف في بدايةِ الثمانينيات الذي راحَ يعرضُ أعمالَه على الأرض. أيضًا نادى المسرحيونَ بكسرِ العلبةِ الإيطاليةِ في المسرح مثل ناجي الحاي وجمال مطر اللذان قدَّما تجربةَ عرضِ أعمالِهما في الهواء الطلق على الرملِ وقرب البحرِ من دون خشبة. وكانتِ القراءاتُ الصحفيةُ والنقديةُ التي ترافقُ هذه التغطياتِ تُشيدُ بفكرةِ التمردِ على الأنماطِ الكلاسيكيةِ وتمجّدُ التجريبَ الفنيَّ الذي شملَ كلَّ تياراتِ الفنونِ والآداب.
ثانيًا: أقفُ هنا أيضًا عند ملاحظةٍ جديرةٍ بالنظر، وهي أنَّ الحداثةَ في الإماراتِ واجهتْ بالفعلِ تحدياتٍ كبيرةٍ أثناءَ ظهورِها في مجتمعٍ تقليدي، ورغمَ بعضِ الرفضِ من المؤسسةِ الثقافيةِ أو أفرادِ المجتمعِ لهذه الأصواتِ الجديدةِ والأفكارِ غير المألوفة، إلا أنَّ المناخَ الثقافيَّ المنفتحَ في الإماراتِ جعلها تتطورُ بشكلٍ طبيعيٍّ وصحيٍّ من غيرِ قسوةٍ أو مبالغة. حيث صارتِ الفنونُ التجريبيةُ تتسيدُ اليومَ الساحةَ الفنيةَ، واستطاع شعراءُ قصيدةِ النثرِ أن يطوّروا تجاربَهم ويراكموها. على عكسِ بعضِ البلدانِ العربيةِ والخليجيةِ التي وصلَ فيها الأمرُ في فترةِ الثمانينيات إلى منعِ الكتبِ وإتلافها بل وإحراقها فقط لكونِها تنادي بالتجديدِ الفنيِّ على صعيدِ الشكل.
ثالثًا: في العام 1984 تأسسَ اتحادُ كُتابٍ وأدباء الإمارات، وفي 1987 أصدرَ أولَ أنطولوجيا شعريةٍ لأبناءِ الإماراتِ بعنوان قصائد من الإمارات، وكان صوتُ الحداثةِ متمثلًا في قصائدِ التفعيلةِ والنثرِ حاضرًا بقوةٍ في هذا الكتاب، بل إنه يمثلُ نحو 50% من محتواه، وهذا مؤشرٌ مهمٌّ على قوةِ حضورِ شعرِ الحداثةِ في ذلك الوقت. وقد تشرفتُ بالمشاركةِ في هذا الكتابِ بقصيدةِ نثر مع مجموعة من شعراء البدايات الأولى لتجارب القصيدة الجديدة في الامارات. وكم أتمنى أن تُعاد تلك التجربة الغنية بإصدار موسوعة جديدة تضم قصائد شعراء الإمارات منذ البدايات حتى اليوم.
رابعًا: أسهمَ اتحادُ كُتابٍ وأدباء الإمارات في نشرِ المجموعاتِ الشعريةِ الجديدةِ لشعراءِ قصيدةِ التفعيلةِ والنثر، بل انحازَ أيضًا لنشرِ كتبِ الشعراءِ الخليجيينَ والعربِ المقيمينَ في الإمارات ومن خارجها. ولعبتْ مجلةُ شؤون أدبية التي تصدرُ عن الاتحادِ دورًا حيويًا في ترسيخِ حضورِ صوتِ الحداثةِ الإماراتيةِ على المستوى العربي، قبل أن تتراجعَ لاحقًا عن هذا الدور. أيضا بدأ صوت القصيدة الجديدة يصل الى الخارج حيث فازت مجموعة (ليل) لخالد البدور بجائزة يوسف الخال في العام 1992، كذلك صارت دور النشر العربية المعروفة في لبنان ومصر تنشر مجموعاتنا الشعرية الجديدة من ضمن سلسلة تضم أبرز التجارب الشعرية العربية الشابة.
خامسًا: يُلاحظُ أننا عند منتصفِ الثمانينياتِ صرنا نستوعبُ أصواتَ الحداثةِ الشِّعريةِ الجديدةِ بزخمٍ أعلى من تجاربِ التفعيلةِ والعمود. حيث ظهرتْ أسماءٌ كثيرةٌ تكتبُ قصيدةَ النثرِ وتنشرُ إنتاجَها في الصحفِ والمجلاتِ، ومن بينها إبراهيم الملا، وعبدالله السبب، والهنوف محمد، ومسعود أمر الله، وعبدالله عبدالوهاب، وأحمد العسم ومها خالد وآخرين. كما ظهرتْ أيضًا تجاربُ إصدارِ النشراتِ الأدبيةِ الحرة مثل (أشلاء الأرانب القزحية) التي شارك فيها مرعي الحليان وعلي العندل، ونشرة (رماد) مع مسعود أمر الله التي تحولتْ لاحقًا إلى نشرة (رؤى)، حيثُ استقطبتْ في عددٍ منها الشاعرَ البحرينيَّ الكبيرَ قاسم حداد. وكان يتمُّ طبعُ هذه النشراتِ وتوزيعُها يدويًّا بين الأصدقاءِ من غيرِ ترخيصٍ رسمي.
سادسًا: شهدتِ الإماراتُ منذ الثمانينياتِ ظاهرةَ الكتابةِ باسمٍ مستعار، وبالأخصِّ الأسماءُ النسائيةُ من العائلاتِ المحافظةِ أو تلك التي تخشى مواجهةَ المجتمع. ورغمَ وجودِ هذه الظاهرةِ في الشِّعرِ الشعبيِّ مثل بنت البادية – قطوف – ريم البوادي وغيرها، إلا أنها في ظاهرةِ الحداثةِ تبدو غيرَ مألوفة. وأتمنى لو تكونَ هناكَ دراسةٌ مستفيضةٌ حولَ هذه الأسماءِ التي كانتْ تنشرُ القصصَ القصيرةَ والقصائدَ بأسماءٍ مستعارةٍ في الصفحاتِ الثقافيةِ لجرائدِ الاتحاد – الخليج – البيان وبعض المجلات، وربما كانتْ أسماءُ بعضِ الرجالِ أيضًا مستعارة.
سابعًا: ظلَّ النقدُ الأدبيُّ الموازي لتجربةِ الحداثةِ الشِّعريةِ متأخرًا عنها. حيثُ لم تكنْ هناك قراءاتٌ في التجربةِ الجديدةِ حتى منتصفِ الثمانينياتِ إلا فيما ندر، ثم من بعد ذلك بدأتْ مجلةُ شؤون أدبية تقدمُ بعضَ القراءاتِ الانطباعيةِ والتحليلية. ثم في بدايةِ التسعينياتِ صار بعضُ النقادِ العرب يقدمونَ قراءاتٍ صحفيةً للتجربة، إلى أنْ تطورَ الأمرُ لاحقًا إلى إصدارِ كتبٍ تقرأُ التجربةَ الشِّعريةَ ككل أو بعضها. لكنها في الأغلب تميلُ إلى الجانبِ الأكاديميِّ لغرضِ الدراسةِ الجامعية. أما ما اشتهرَ من هذه الدراساتِ فهو قليل، ولا يتجاوزُ 15 كتابًا كما أظن، كلها حاولتْ في مجلدٍ واحدٍ أنْ تقرأَ التجربةَ الشِّعريةَ في الإماراتِ على العمومِ ولم تخصصْ أو تركّزْ النظرَ في عمقِ علاماتِ التجديدِ على مستوى اللغةِ والصياغةِ وتكوينِ البنيةِ المعماريةِ للنصِّ الشِّعريِّ الجديد. وتحولاته الفكرية والفلسفية.
ملاحظة: ربما لم تتسع المقالة لاستيعاب جميع الأسماء الواردة في تلك المراحل الأولى، لكن الغرض هنا ليس تدوين وتوثيق التجارب كلها، بقدر ما هو سعيٌ لتقديم صورة مقربة لتجربة مهمة في تاريخ النهضة الثقافية على مستوى الشعر في دولة الإمارات العربية المتحدة.