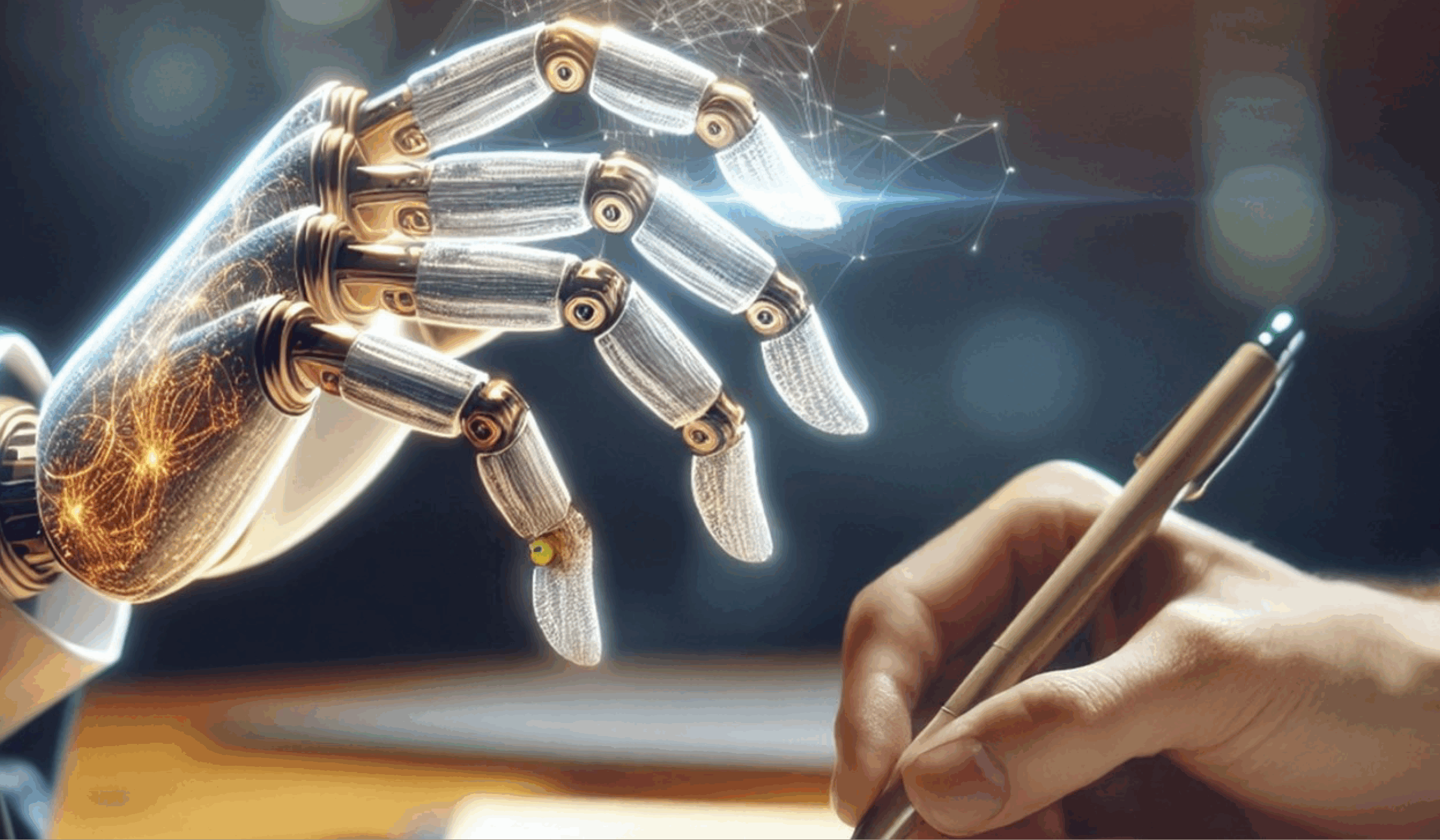وئام غداس
كاتبة تونسية
أنا واحدةٌ ممن بدأوا في كتابة “الشِّعر” على “فيسبوك”، قبل عقد من الزمن، في الوقت الذي كانت الهجمة على هذه الظاهرة الجديدة، من الشعراء والنقاد والمثقفين في أوجها، وفي شكلها الأشدّ قسوة وضراوة. لن أنسى أبدًا طيف العار الذي كان يصاحب نصوصي، ويلازمها، رغم التظاهر بالثقة وعدم الاكتراث. شعوران كان يغذيهما احتفاء الأصدقاء في فيسبوك، وهم غالبًا، إمَّا أشخاص مثلي يحاولون فرض هذا الشكل الجديد في نشر النصوص، أو أشخاص عاديون، ليسوا شعراء، واهتماماتهم لا تضمُّ الشِّعر أو حتى الأدب، ليسوا من النخبة الأدبية -وإن كانوا من نُخَب أخرى-، لكنهم خصوصًا لا يغارون على الشِّعر ولا يرونه ملكية حصرية، قرؤوا كلمات أثَّرت بهم أو تقاطعت مع احدى تجاربهم الحياتية وهذا كل شيء! (لا أحب أن أقفز فوق نوع آخر في هذا الجمهور طبعًا، وهم المعجبون بصاحب/ة النص بقطع النظر عما كتب/ت، ومهما كان ما كتب/ت!).
تستطيع أن تتخيل كيف يكتب شخص، وهو يشعر بالخجل مما يكتبه، ينشر نصَّه على أحد مواقع التواصل، ثم يتمنى أن يختفي من الوجود أو تنشق الأرض وتبتلعه، على الرغم من شعوره العميق أنَّ ما كتبه جيِّد، فأنا أيضًا لست شخصًا قادمًا من بعيد، لقد تنفَّستُ الكتب والأدب شِعرًا ورواية وقصة منذ تعلمت القراءة والكتابة، وأعتبر نفسي مؤهلة لتقييم ما أكتبه تقييمًا سليمًا، لا تنقصه الموضوعية، لكنها سلطة الانتقاد اللاذع، والرفض الأعمى، والعنجهية المركّّبة التي قادتها في ذلك الوقت جيوش من “الكبار” و”المهمين” و”الأكاديميين” و”الفاعلين” و”ذوي التاريخ والمكانة”، أصحاب الدواوين، الذين خبروا معنى المرور بكل تلك المراحل المضنية لتخرج قصائدهم في كتاب ورقي، ومعنى تحقيق شيء من التوافق بين ناشر حساباته تختلف جذريًّا مع حساباته كشاعر، ومعنى النضال حرفيًّا حتى يُقرأ هذا الكتاب وهي الغاية الأساسية من وراء هذه الرحلة العجيبة، والتي لا تتحقق إلا بنسبة ضئيلة جدًا، إن لم تكن معدومة، من جمهور محدود ونخبوي، وهو الجمهور نفسه الذي سيحضر الأمسيات الشِعرية ليسمع هذه القصائد، الأمسيات النادرة والقليلة والتي سيعاني هذا الشاعر ليتلقى دعوة إليها، ويُحارِب ويُحابي ويغضب ويسجِّل المواقف.
لكن الشاعر تعوَّد على ذلك، تعوَّد عليه إلى الحد الذي بات معه انتشار شاعر أو جماهريته -حتى لو كان هو- أمرًا مرعبًا بالنسبة له، ليس هذا فقط، إن النجاح والشهرة ونسب البيع المرتفعة شيء يتنافى وجوهر الشِعر وكتابته، وهذا غالبًا ما يكون الطريق المهيأ للحكم البديهي: أن هذا ليس شاعرًا وما يكتبه ليس شِعرًا، الشِعر توأم اليأس والفقر، ومن ليس له هذان الأخان فهو “لقيط”!
عندما جاءت وسائل التواصل غيَّرت كل شيء، وهذا التغيير في الحقيقة ليس سوى جزءٍ من طبيعة الحياة التي تتقدم على الدوام، فإذا كانت التكنولوجيا والرقمية قد طالت كل جوانب الحياة، فلماذا ستستثني الشِّعر؟ وهؤلاء الذين استنكروا ذلك، فليتذكروا أن الشعر كان يُلقَى شفاهةً في الأسواق، ثم ذهب إلى المخطوطات الورقية ومن ثم إلى المطبعة، وداخل هذه السيرورة فهو الآن في قلب وسائل التواصل الاجتماعي والوسائط الرقمية، التي باتت تعد ركيزةً عضويةً من ركائز واقعنا الراهن، وما لا يوجد داخلها، لن يوجد في الحياة، هكذا بهذه البساطة. لم يعد الشعر حبيس الكتب والدواوين، بل صار يتنفس في “فيسبوك” و”إنستغرام” و”تويتر” و”تيك توك”، حيث أصبح للشعر شكل جديد، وجمهور جديد، وربما وظيفة جديدة.
هكذا انفجرت تجارب شعرية لا يمكن عدُّها أو حصرها، وخرج الشِّعر من أشخاص عاديين، غير معروفين ولا مكرَّسين، فقط حلُموا بكتابته. لم يعد الشعر حِكرًا على أحدٍ، أصبح لكل شخص الحق أن يكتب وينشر، ما فتح المجال أمام أصوات جديدة متنوعة، من الإجحاف عدم الاعتراف أنَّ كثيرًا منها كان رائعًا. شِعر جاء من أشخاص عاديين وذهب إلى أشخاص مثلهم، ليسوا شعراء، ولا نقادًا، وأحيانًا لا يكونون قراءً متمرِّسين أو متذوقين للأدب، إنها نصوص للجميع، حتى من لا يقرأ الشِعر عادةً. هذا شِعر جديد شرطه ليس الثقافة الأدبية بل الإحساس، إحساس عميق بالأشخاص والأشياء والمواقف، وهذا ما قد يتوفر في بائع خضار على الناصية، ولا يتوفر في شخص درس عشرة سنين في الجامعة وقرأ ألف كتاب! وهنا يحضرني ما قاله الشاعر الفرنسي بول فاليري قبل قرن من هذا الزمن أنّّ: “هنالك شعراء لم يكتبوا قصيدة واحدة في حياتهم، وقتلة لم يسفكوا قطرة واحدة من الدم”.
انتقلنا من زمن كان يُنظر فيه إلى الشعراء كأصوات فنية أو فكرية متميزة، وجزء من النخبة الثقافية، غير المتاحة، إلى شعراء هم أقرب إلى مؤثرين، يُطلق عليهم مثلًا اسم: “الإنستابويترز”، أي شعراء الإنستغرام، يتواجدون بنصوصهم أو هم بأنفسهم في تواصل وتفاعل مباشر ودائم مع قرائهم، ويدخلون السوق التجارية (بيع كتب، منتجات، تعاونات…) شعراء ينشرون نصوصًا قصيرة مرفقة بصورة أو تصميم بسيط لتصل في ثانية إلى آلاف القراء والمتابعين حول العالم بضغطة زر، دون حاجة لدور نشر أو إلى منصات تقليدية. على غرار روبي كور الشاعرة الكندية من أصول هندية، التي برزت على “إنستغرام” بكتابة أبيات قصيرة مع رسومات بسيطة، والتي حقق ديوانها حليب وعسل مبيعات خيالية، ولانج ليف الشاعرة والفنانة النيوزيلندية ذات الأصول الكمبودية، الناشطة بكثافة على مواقع مثل “أنستغرام” و”فيسبوك”، كانت قصائدها ذات الطابع التأملي والرومنسي، مادة مهمَّة لكثير من المترجمين في كل أنحاء العالم، والعالم العربي من ضمنها، ما جعلها تصل بعيدًا بنصوصها، بفضل مواقع التواصل. والشاعر المجهول الذي بات يُعدُّ ظاهرة، والذي يتخذ اسم “أتيكوس” كاسم مستعار، وهو ما أضاف غموضًا جذب جمهور وسائل التواصل إليه. ينشر أتيكوس أبياتًا قصيرة غالبًا بالإنجليزية على “إنستغرام”، تعتمد على الرومانسية والوجودية المبسطة، أسلوبه بسيط، قصير، وصوري، يناسب التصفح السريع. نصوصه هذه تحوَّلت إلى اقتباسات تجوب العالم، وبفضل هذا الانتشار نجح في تحويل نصوصه الرقمية إلى كتب شِعرية بِيعَت منها ملايين النسخ.
لكن “إنستغرام” ليس المنصة الوحيدة، فالكثير من الشعراء العرب والعالميين وجدوا في “فيسبوك” مساحة للتفاعل الحيّ مع قرائهم، وفي “تويتر” مجالًا لتجريب “القصيدة القصيرة” أو “الهايكو الرقمي” في 280 حرف فقط.
في الوقت الذي كانت أهم القضايا الوجودية والفلسفية والسياسية منوطة بالشِّعر، أصبح الشِّعر اليوم يركِّز على مشاعر شخصية ويومية، وتجارب فردية، مثل الحب، والانكسار، والقلق، والشفاء الذاتي، فأصبح الشِعر فنًّا قريبًا جدًا من الناس، ذلك لأنه بات يلامسهم أكثر. إنه فنٌّ عظيم يتكلم عن أشياء بسيطة وعادية في حياتهم، كانت في السابق بالنسبة إليه -أي الشِعر- أمورًا تافهة! وهنا، عند هذه النقطة سيبرز سؤال: من الذي قسَّم الألم الإنساني إلى قضايا كبيرة وأخرى صغيرة؟ ومن قال إنَّ الآلام الفردية، الشخصية جدًّا والأشدّ حميمية يجب أن تتفسَّخ أمام القضايا الجمعية؟!
لغة الشعر الصلبة ذات البناء اللغوي المعقد، والصور البلاغية العميقة، والإحالات الثقافية والتاريخية، المكتوبة في نصوص طويلة أو متوسطة، أصبحت اليوم لغةً سهلةً وبسيطةً ومباشرة، مفهومةً لأي شخص. نحن بصدد نصوص قصيرة، أقرب إلى أن تكون “اقتباسًا”، وهو أمر على الرغم من عيوبه، إلا أنه يجعل قراءة الشعر أمرًا سهلًا ومتاحًا وبالمجان فوق ذلك.
نعم لقد أعادت منصَّات مثل “فيسبوك” و”إنستغرام” و”تيك توك” وغيرها إحياء الشعر لجمهور شابّ كان بعيدًا عنه، لكن هل هذا كل شيء؟
قطعًا لا، ولأكون موضوعية لن أنكر ما يبدو واضحًا، وهو أن كل هذه الإيجابيات لم تأتِ دون سلبيات على الشِعر والشعراء وحتى القراء. إنَّ فَرْضَ هذه المنصَّات الرقمية للإيقاع السريع دفَعَ بعض الشعراء إلى اختصار النصوص واختزالها، وجعل بناءها الشعري أعرجَ، فلم يعد تقريبًا من الممكن التحدث عن قصائد بل عن اقتباسات تصلح للمشاركة السريعة، شكَّلَتْ خطر التسطيح لفنٍّ أول ما يُميِّزه هو العمق. كما سهَّلَتْ السطو والسرقات الأدبية، وانتهاك حقوق الملكية، فهذه الاقتباسات تُلصَق وتُنشر دون الإشارة لصاحبها، بل أكثر من ذلك فهي تُنسَبْ بسهولة لشخص آخر.
أما هاجس الجذب الذي يستبدُّ بكل من يصنع محتوى رقميًا، فلم يستثنِ الشعراء بالطبع، إذْ أصبحت الصورة ضرورة لمرافقة النص الشعري، (ستفهم الآن لماذا أشرتُ في بداية المقال إلى مُعجبي الكاتِب وليس النص، إذْ كثيرٌ من الشعراء، والشاعرات خصوصًا الآن، يُرفقن صورهن الشخصية مع نصوصهن، وهو أغرب ما رأيته بهذا الصدد!) وهو ما نلاحظه بكثافة في منصات كـ”إنستغرام” و”تيك توك”، فتكون الأبيات، غالبًا، مجرد جزء من تصميم أو فيديو، حيث تأخذ الصورة الأهمية الأكبر، ويصبح النصُّ مكمِّلًا لا محوريًّا، فتفقد القصيدة هالتَها، خصوصًا وهي جزءٌ من محتوى آخر ضخم ومتنوع وسريع، يجعل وجود الشِّعر بينها نوعًا من الاستخفاف به. الاستخفاف الذي يبلغ ذروته مع انتشار النصوص الضعيفة، فمع سهولة النشر أصبح الجميع قادرًا على نشر نصوصه دون نقد أو مراجعة أو تحرير، ما خلق فوضى متعلقة بجودة النصوص وتراجع المعايير.
في النهاية، هنالك حقيقة لا يمكن لشيء تغييرها، لا الزمن، ولا تغيُّر الواقع ووسائطه، وهي أن الشعر ملازم للحياة، يستبطن جِلْدَها، ويفتح نوافذ الروح على العالم. الرقمية غيَّرت لِباسَهُ وقواعده، لكنها لا تقدر على إفساده ولا إنقاذه طبعًا، يمكن النظر إلى المسألة على أنها ركَّبت له أجنحة للعبور بعيدًا. التحدي اليوم ليس رفض الرقمية ولا الانصهار الكامل فيها، بل إيجاد توازن يحفظ جوهر الشعر ويستفيد من أدوات العصر. أما الشِعر الضعيف الذي يخشى الكثيرون أن يُسيء إلى قيمة الشعر، وهذه الأقدام الكثيرة التي تتطلع إلى لمس هذا البساط الأحمر المخمليّ، ولو بطرف إصبع واحد، ليست مجرمة. من حق الجميع أن يظنوا أنهم شعراء، في واقع صعب وضاغط كالذي نعيشه، حيث يصبح الذهاب فيه إلى الفنون أفضل من الذهاب إلى البشاعة، حتى تغربل آلة الزمن الشِعر من غيره وهو أمر بدهيٌّ، لا يجب أن يشغل أحدًا، لأنه ليس دوره.