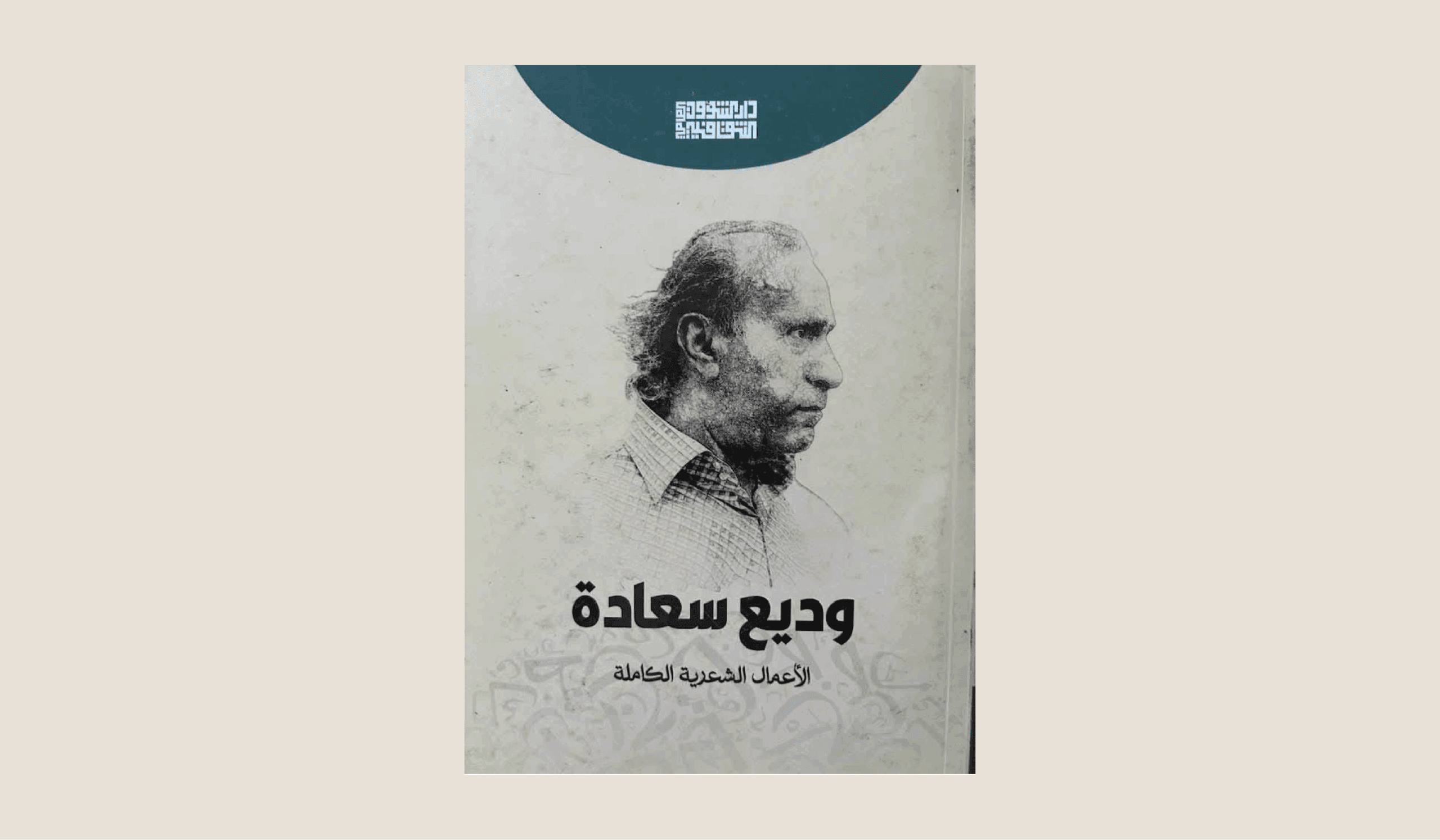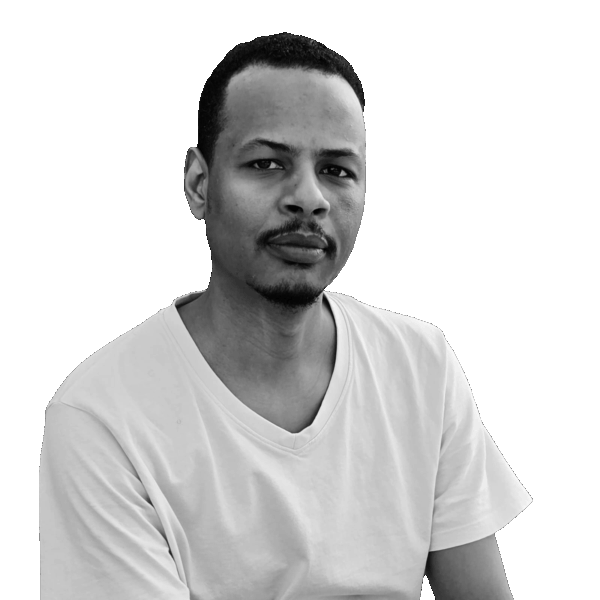
محمد مركح
شاعر وكاتب سوداني
علاقتي بوديع سعادة ليست علاقة قارئ بشاعر، ولا علاقة شاعر بشاعر؛ هي علاقة في صميمها تجمع بين يتيمين. فارتباطي بشعره لا صلة له بدوره وقيمته في تثوير النَّصِّ الشعري الحديث والانفلات به عن مداراته التقليدية، بل لأن هذا الشاعر بالتحديد أعود إليه كلما تذكَّرتُ جسدَ أبي ممدَّدًا على طاولة خشبية، وجرحًا يمتد من أعلى صدره إلى أسفل بطنه، ويأخذ شكل الصليب. تلك العودة شكل من أشكال «الندم المبتسم» الذي يجعل من «قصيدة جميلة تُنسينا أو تجعلنا نسامح كربةً قديمة»، وما بين القوسين لـغاستون باشلار.
كل الشعر الذي قرأته بعد ذلك كان لاستيعاب ذلك المشهد، ولفهم ما حدث لي في تلك اللحظة المربكة والمعقَّدة. الشعر لم يكن مستحيلًا بعد غياب أبي، بل ممكنًا أكثر من أي وقت مضى، وبالأخص لو كان لشاعر مثل وديع سعادة، والذي تعلَّمتُ منه في بداياتي الشعرية كيفية تحويل الحزن الكامن في هديل الحمام إلى كلمات، وأنا أعاين افتقادي لحضور أبي عند كل صباح.
أكتبُ عن وديع سعادة لأحتفي بحميمية الخسارة ودفء الحسرة الرقيقة، بالشعر الذي يبعث في الأحاسيس الأصيلة دفقات هادرة من الخيال الخصب:
«سأذهب إلى الغابة مع الحطَّابين
وبفأس دهشتهم
أقطع أحلامي وألقيها في النار.
يقول الحطَّابون:
اليابسُ يُقطع».
سألني صديقي قبل أكثر من عشرة أعوام عن جدوى الشعر؛ وقتها تعثَّرتُ في صياغة ردٍّ مناسب، ووجدت أن التحذلق والتلفيق سيتخلَّلان أي إجابة تبدِّد ريبته وشكَّه، فالشعر وقتها لم يتجاوز كونه نشيجًا طفوليًا على صدر اللغة. لو سألني الآن سأصمت أيضًا، وسأمنحه دواوين: «رتق الهواء»، و«غبار»، و«المياه المياه»، و«مقعد راكب غادر الباص»، و«بسبب غيمة على الأرجح». سأترك مهمة الإجابة لوديع سعادة؛ فهو شاعر لا يجيد الادِّعاءات والتنظير، فقط يكتب شعرًا خالصًا يحلبه من ضرع مخيِّلة فائرة، شعرًا يلتحم بفداحة تجربتنا على هذا العالم. هو شاعر يقدِّمُ الشعر كما نحتاجه، الشعر كما نفتقده.
من وديع سعادة أدركت أن قصائدنا نكتبها لآباء لا يوجدون، آباء غادروا وتركوا خلفهم أبناءً يتفاقم بداخلهم اليتم والوحدة والشجن:
«لماذا أتذكَّرُ أبي الآن؟
كنتُ طفلًا حين أوصلته إلى القبر
لكنهم كانوا ينظرون إليَّ
وكان من اللياقة أن أشيخَ أمامهم».
ينطلق وديع سعادة في هاجسه الشعري من ممكنات الاحتراق وخيارات الاشتعال، يكتب بذاكرة متفحِّمَة تؤسِّس لكينونة تخترع الرماد أبجدية، وتستعيد تجربتها في حفلة الشواء الكوني بكامل الحفاوة:
«حين ودَّعتُه لآخر مرة
كان ذلك على الشاطئ
ثم تصاعد من بيتنا دخانٌ كثيفٌ
وكان للدخان رائحة لحم محروق
وصار أبي هيكلًا عظميًا أسود
صعدتُ وألقيتُ نظرة أخيرة على فحمه
مضيتُ حاملًا وحدي حطب الحياة».
وديع كائنٌ هشٌّ يرفض الشعر الذي يقترح ذاتًا بطولية ومتضخِّمة، يرفض مهمَّة تستعير وجودها الباهت في نصّ ممتلئ بالركاكة؛ فالنص الذي لا يبرِز توعُّك الروح، والتهاب الوعي، وتعرُّق الجسد، ينعرج بالقصيدة إلى مأزق الفصاحة الساذجة. لا بدَّ للشاعر من امتلاك ديناميت يفجِّر به اللغة، ويبعثر أناقتها المزعومة، بتوريطها في الحضيض، والمهمَّش، والمرفوض، والمهمل، لتنخرط بشكل جدِّي مع هذا العبث واللاشيء، وتعترف بمدى تفاهة وخِفَّة سلطتها على حضور احترق بالغياب. الشعر عنده كتابة تحت درجة حرارة عالية من السخط لإنقاذ نفسه من حالة التلبُّس بفضيحة الحياة:
«أعترف الآن أنِّي اخترعت أكاذيب كثيرة من الكلمات
ما قلته وما كتبته لم يكن سوى كذب
ابن لقيط لمخيِّلَة مجنونة
ما قلته وكتبته كان خيانة لبراءة الكلمات
هذه التي أطالبها بالبراءة
وأمارس العهر معها
لقد ظلمتُ الغيم
وظلمتُ ريش الطيور ونشارة الخشب
ظلمتُ الشجر حين قلتُ يثمر من النظرات
والجبال إذا ألبستها أقدامًا
وظلمتُ الموتى حين أعدتُ عظامهم إلى الحياة،
والحياة حين أعدتُها إلى الموتى».
نصوصه تشهق بالمخيِّلَة وتنغرز عميقًا في الشعور:
«نتسلَّقُ ضحكاتنا
لأن صراخنا شاهقٌ جدًا».
فالشعر الحقيقي هو الذي يقودك بإصرار إلى اللا-وجه واللا-اسم، الذي يفضح عُريكَ من رداء محاكٍ برشاقة السقوط، لتنتصب عاريًا دون ملامح:
«نزلتُ آخر نقطة. كنتُ في غيمةٍ ونزلتُ.
هل أنا الباحث عن شخص ذائب أم أنا الذائب؟
أم أنِّي، من كثرة البحث عن ذوبانه، ذبتُ مثله».
الشعر صيرورة تتراوح بين الطفولة والموت، باعتبار أن الشعر لا يتحقَّق شرطه الجمالي إلا بمجابهة الذات. الطفولة بصياغة قراءة جديدة للمفهوم البارتي، نسبة إلى الناقد الفرنسي رولان بارت «الكتابة من درجة الصفر»، باقتراح الكتابة ببراءة البدايات، وليس كما وقر في خلد البعض بابتدار الكتابة دون تحيُّزات ومضمرات مسبقة. فالشعر موقف من الوجود لا يتأسَّس على فراغ، بل ينهض من وعي يكتنز رؤية شاملة وإدراكًا كليًّا. والموت، كحقيقة حتمية ونهائية، لا تجدي معها أنصاف الحلول، بل محفِّزًا يستنفر مكنون التجربة الشخصية، ويتمّ التصالح معه بصدق الأجوبة؛ فالشعر في جوهره افتتاح للتساؤلات. هنا يطلُّ الغياب كتساؤل مركزي في مشروع وديع سعادة الشعري، ويَسِمُ الكثير من نصوصه، ويأتي ديوانه «نص الغياب» شاهدًا على هذا الهاجس الوجودي:
«أمدُّ إشارات يدي إلى الأصوات التي صارت بعيدة،
وأعيدها إلى الحنجرة.
أفرش لها قميصًا تحت صوف الهندباء،
وأنام قربها.
في هذا المكان الضيِّق،
حيث يلعب النيام والموتى الورق،
ويتبادلون الأدوار».
للغياب في شعر وديع سعادة أكثر من صورة؛ فمرَّةً يكتب عن غياب المكان:
«ويقول الذين بقوا في القرية
أن كلبًا غريبًا كان يأتي كل مساء
ويعوي أمام بيوتهم».
ومرَّةً أخرى يأتي كغياب للمعنى:
«من يحبُّ أولاده لا يورِّثُهم صورته
لا يهديهم ذاته
لا يترك لهم ذاكرة
…
من يحبُّ أولاده يمنحهم النسيان».
كما أن الحزن في شعر وديع أصيل، والخيبة راسخة، فليس مبذولًا للجميع أن يقنعوا بجدوى حزنهم:
«لا أخال الأرض محمولةً إلا
بكثافة الآهات.
……
كل هذه الرياح ليست سوى
آهات بشر».
شكرًا وديع، لأنك بكل هذا الصدق، وهذا الجرح، وهذه اللغة الحارقة التي تمضي مليًّا داخل الروح. لا أملك خطَّة معيَّنة لهذه الليلة سوى الحديث مع امرأة سخية تمنح المساء نايًا يعانق به وجه القمر البعيد، وقراءة نصوصك التي تمنح للمساء إخوة!